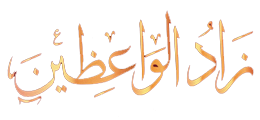عدد جمادى الأولى 1437هـ
- التفاصيل
- كتب بواسطة: اللجنة العلمية
- المجموعة: عدد جمادى الأولى 1437هـ
- الزيارات: 9734
سلسلة الأساليب النبوية
في
(الدعوة والوعظ والتربية والتعليم ومعالجة الأخطاء)

أولا: وقفات مع بعض الأساليب النبوية في التربية والتعليم
إن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرّ بمختلف الظروف والأحوال التي يمكن أن يمر بها معلم أو مربٍّ في أي زمانٍ ومكان؛ فما من حالة يمر بها المربي أو المعلم إلا ويجدها نفسها أو مثلها أو شبهها أو قريباً منها في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- لقد عاش النبي -صلى الله عليه وسلم- الفقر والغنى، والأمن والخوف، والقوة والضعف، والنصر والهزيمة، عاش اليتم والعزوبة والزوجية والأبوة. . فكان يتعامل مع كل مرحلة وكل حالة بما يناسبها.
ولقد ساس النبي -صلى الله عليه وسلم- العرب، ودعاهم وعلَّمهم وأحسن تربيتهم؛ مع قسوة قلوبهم وخشونة أخلاقهم، وجفاء طباعهم وتنافر أمزجتهم، لقد كان حال العرب كما وصفهم جعفر بن أبي طالب ـ -رضي الله عنه- ـ بقوله: "كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القويُّ منا الضعيف. . "(1)
فاحتمل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما هم فيه من جفاء، وصبر منهم على الأذى، حتى كانوا خير أمـة بعد أن لم يكن لهم قيمة ولا وزن {وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ} [الجمعة: 2].
إن المتأمل في هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيرته يرى كثرة الوسائل والأساليب التي انتهجها -صلى الله عليه وسلم- في تعليمه للأمة وتربيته لها، وإن الإحاطة بكل ذلك قد لا يكون ممكناً ولا مناسباً في مثل هذه العجالة، ولكني أقف مع بعض هذه الأساليب النبوية التي أرى الحاجة ماسة إلى التنبيه عليها:
■ أولاً: الحفاوة والترحيب وحسن الاستقبال:
أحياناً نتعامل مع المتعلم والمدعو والمتربي على أننا أصحاب منَّةٍ عليه وتفضل، ولذا نرى أنه لا حاجة إلى القيام بشيء من الترحيب والحفاوة وحسن الاستقبال، بل قد نعتبر مجرد قبولنا له كافياً في الإكرام، وربما يشعر الأب والمربي والداعية أياً كان أن الحق له؛ فهو يطالب المتربي به. والحقيقة أن للأب والمربي حقاً كبيراً، لكن هذا الحق لن يتحقق إلا حين يُعرف الولد والمتربي والمدعو بذلك ويغرس في قلبه إكرام أهل الفضل من خلال أساليب تربوية مشوقة وخطوات يقوم بها الأب والمربي.
ولقد كان من يقابل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو لأول وهلة يجد عنده من الحفاوة والترحيب وحسن الاستقبال ما يجعل النفوس تنجذب إليه وتأنس بحديثه.
جاء صفوان بن عسال ـ -رضي الله عنه- ـ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إني جئت أطلب العلم. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- "مرحباً بطالب العلم؛ إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب…(2)"، كيف سيكون أثر هذا الترحيب وتلك الحفاوة في نفس صفوان، هل تراه يزهد في طلب العلم بعد ذلك؟ في بعض الأحيان يأتـي الطالب ليشـارك في حلقة قـرآن أو منشط خيري فيقابـل بشــيء مــن البـرود (. . لا بأس، اجلس مع زملائك. . ) دون أن يسمع كلمة ترحيب، بل ربما استُقبل بعارضة من الشروط المشددة (شروط القبول) والتي ربما جعلته يعود أدراجه. إن مما يُذكر فيُشكر أن بعض دور التعليم والمناشط الخيرية ربما جعلت حفل استقبال وترحيب بالأعضاء الجدد ذا أثر كبير في بعث الرغبة في النفوس.
– وعن أبي رفاعة ـ -رضي الله عنه- ـ قال: "انتهيت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل عليَّ رسول الله ( وترك خطبته حتى انتهى إليَّ، فأُتي بكرسيٍّ حسبت قوائمه حديداً. قال: فقعد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها(3).
عجيب والله! يوقف الخطبة، ويجلس للمتعلم! أي تكريم فوق هذا وأي حفاوة، وكم سيصنع هذا الأسلوب من رغبة في نفس المتعلم والطالب! ! هل نستطيع نحن المعلمين أو المربين أن نقوم عن وجبة الإفطار ـ في المدرسة مثلاً ـ لنجيب الطالب عن مسألته؟ وحين يقطع علينا المتربي لذة النوم باتصال هاتفي لحل مشكلة، أو إجابة عن سؤال هل سيجد الترحيب منا وطيب النفس؟
– ولقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستقبل الوفود ويحسن وفادتهم، ويتخذ لذلك لباساً خاصاً وخطيباً يخطب بين يديه إشعاراً منه بمزيد الاهتمام بهم؛ فلما أتى وفد عبد القيس رحب بهم -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامى(4). . "، ولما قدم الأشعريون أهل اليمن قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أتاكم أهل اليمن هم أرقُّ أفئدة، وألين قلوباً، الإيمان يمان، والحكمة يمانية"(5). إن القلم ليعجز عن التعبير عن جمال هذا الخُلُق وأثره في النفوس، ولو أردنا أن نقف مع كل موقف من هذه المواقف لنتأمل فيه ونقف على الأثر الذي يحدثه في النفوس لطال بنا ذلك، وفيما ذكرنا كفاية.
■ ثانياً: الرفق والرحمة وحسن التأني:
{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159].
لقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الرفق سبباً من أسباب الكمال والنجاح؛ فعن عائشة ـ -رضي الله عنها- ـ قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه"(6). وفي حديث جرير بن عبد الله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حُرِمَ الرفق حُرِمَ الخير"(7).
على هذه القاعدة العظيمة في التعامل (الرفق والرحمة) كان تعامل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه؛ فعن أبي هريرة ـ رضي اله عنه ـ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالـد أُعَلِّمُكُم؛ فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها…"(8)، فتأمل كيف ابتدأ النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الأسلوب اللطيف في التعليم، وكم سيكون له من أثر في نفس السامع. . ! !
وعن مالك بن الحويرث ـ -رضي الله عنه- ـ قال: أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رحيماً رفيقاً؛ فلما ظن أنَّا قد اشتقنا أهلنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلِّموهم". . الحديث. إن هذه الرحمة من النبي -صلى الله عليه وسلم- بهؤلاء الشباب فيها التوجيه إلى ضرورة مراعاة طبائع النفوس، الشيء الذي قد يغفل عنه بعض المربين بحجة (الجدية والحزم) فربما كلفوا النفوس ما لا تطيق، وحَمَلوها على ما يسبب لها الانقطاع.
وتتأكد الحاجة إلى الرفق والرحمة عند وقوع الخطأ غير المتعمد؛ لأن النفوس أحياناً قد يستثيرها الخطأ فتنسى التعامل معه بالرحمة والرفق، وتميل بقوةٍ إلى الردع والتأديب؛ فعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن(9).
وعن أنس ـ -رضي الله عنه- ـ قال: جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما قضى بوله أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذَنوب من ماء فأُهريق عليه"(10)، وفي رواية: فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر؛ إنما هي لذكر الله ـ عزَّ وجل ـ والصلاة وقراءة القرآن".
تأمل هذا الموقف لو وقع في مسجد حيِّك، لو أن ـ رضيعاً ـ بال في مصلى النساء فكم ستتابع على أمه كلمات التعنيف وربما السب، وسيكون ذلك حديث جماعة المسجد، وأهل الحي أياماً.
إن التعامل بالرفق والرحمة يورث النفس نوعاً من الطمأنينة والهدوء، ويجعل تَفَهُّم المشكلة والتعامل معها أكثر نجاحاً وتحقيقاً للأهداف بخلاف ما لو صَحِب ذلك نوعٌ من التوتر.
■ ثالثاً: الثناء والتشجيع:
الثناء والتشجيع وتسليط الضوء على مكامن الكمال في النفس البشرية والإشادة بها منهج نبوي كريم، يراد منه بعث النفس على الزيادة، وإثارة النفوس الأخرى نحو الإبداع والمنافسة، وهو مشروط بأن يكون حقاً، وأن يُؤمَن جانب الممدوح، وأن يكون بالقدر الذي يحقق الهدف.
– عن أبي هريرة ـ -رضي الله عنه- ـ قال: يا رسول الله! مَنْ أسعد الناس يوم القيامة؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك، لِـمَا رأيت من حرصك على الحديث…. "(11).
– وعن حذيفة ـ -رضي الله عنه- ـ قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول الله! ابعث إلينا رجلاً أميناً، فقال: لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حقَّ أمينٍ، حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح(12) (وفي رواية) فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة(13).
– وعن أُبي بن كعب ـ -رضي الله عنه- ـ قال -صلى الله عليه وسلم-: "أبا المنذر! أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أبا المنذر! أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت {اللَّهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ الْـحَيُّ الْقَيُّومُ} [آل عمران: 2] قال: فضرب صدري، وقال: لِيَهْنَ لك يا أبا المنذر العلم"(14).
انظر كم في هذه الأحاديث من تشجيع واهتمام ومزيد رعاية وعناية.
كم يبعث التشجيع في نفس المتعلم من حب للعلم، وكم يساعد في تسارع خطوات التربية نحو الأمام، وذلك على عكس ما يأتي به كثرة التأنيب والعتاب واللوم، أو السكوت عن الثناء عند كل نجاح وتفوق.
والثناء والتشجيع قد يستفاد منه في تدعيم سلوك معين أو التوجيه إلى عمل مهم يحسن اكتسابه.
– في حديث ابن عمر ـ -رضي الله عنهما- ـ في الرؤيا التي رآها فقصها على أخته حفصة ـ -رضي الله عنها- ـ فقصتها على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "نِعْمَ الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل". فيا ترى ما أثر ثناء النبي -صلى الله عليه وسلم- على ابن عمر ـ -رضي الله عنه-؟ (قال سالم: فـكان عبد الله، بعـد ذلك، لا ينام من الليل إلا قليلاً)(15).
إن كثيراً من القدرات، وكثيراً من أصحاب الكفاءات يصابون بالضمور، بل ربما يموتون وتمــوت مواهبهــم وقدراتهـم؛ لأنهـم لا يجدون من يدفعهم بكلمة ثناء، أو يرفعهم بعبارة تشجيع.
إننا حين نثني على أصحاب القدرات لسنا نحفظ ونضمن جهـد المجتهـد منهـم فحسب، بل إننا نحــرك نفــوســاً ربمــا لا يحركها أسلوب آخر……. ! !
---
(1) مسند أحمد (1740) وقال محققوه: إسناده حسن.
(2) المعجم الكبير للطبراني (7347) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (71): حسن.
(3) مسلم (876).
(4) البخاري (53)، مسلم (24).
(5) البخاري (4388).
(6) مسلم (2593).
(7) مسلم (2592).
(8) أبو داود (8)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (6): حسن.
(9) مسلم (537).
(10) البخاري (221).
(11) البخاري (99).
(12) مسلم (2420).
(13) مسلم (2419).
(14) أبو داود (1460) وقال الألباني في صحيح أبي داود (1460): صحيح.
(15) البخاري (3738 و3739).
- التفاصيل
- كتب بواسطة: اللجنة العلمية
- المجموعة: عدد جمادى الأولى 1437هـ
- الزيارات: 10625
من آفات الدعاة (الاستعجال)

لما كان الدعاة إلى دين الله -عز وجل- أكثر الناس اتصالا بشرائح المجتمع، وأكثر الناس تفاعلا وتواصلا معهم، وتأثيرًا فيهم وتأثرًا بهم، وطريق الدعوة شاق طويل، ومليء بالآفات والمعوقات، وربما يرجعون بسببها عن الطريق، ويقعدون عن الدعوة، ويتخلفون عن المسير، فتحرمهم الوصول إلى غايتهم، وإصابة هدفهم، ومَنْ استوحش المضي في هذا السبيل بسبب قلَّة الناصر أو المعين، أو استثقل مطارق الأذى؛ فليس له في الريادة نصيب.
هذه الآفة هي "العجلة"، أو إرادة تغيير الواقع في أقل من طرفة عين، دون نظر في العواقب، ودون فهم للظروف والملابسات المحيطة بهذا الواقع، ودون إعداد جيد للمقدمات، أو للأساليب، والوسائل، بحيث يغمض الناس عيونهم ثم يفتحونها، أو ينامون ليلة ثم يستيقظون، فإذا بهم يرون كل شيء عاد إلى وضعه الطبيعي في حياتهم، ووجد كل إنسان إنسانيته، وخلصت الفطرة من كل ما يكدرها ويعكر صفوها!.
ومن هنا قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
والاستعجال معناه: طلب الأمر قبل مجيئه، وتحريه قبل أوانه(1).
ثالثا: مــن مظاهـر الاستعجــال:
1- ضم أشخاص إلى قافلة الدعاة قبل الاستيثاق، والتأكد من مواهبهم، وقدراتهم، واستعداداتهم.
2- الارتقاء ببعض الدعاة إلى مستوى رفيع قبل اكتمال نضجهم، واستواء شخصيتهم.
3- القيام بتصرفات طائشة صغيرة تضر بالدعوة، ولا تفيدها.
أسباب الاستعجال:
1- النشأة الأولى: والتي يمكن أن تكون الطبيعة التي خلق عليها، أو البيئة التي نشأ فيها.
أما عن الطبيعة التي خلق عليها: فإن الاستعجال طبيعة مركوزة في فطرة الإنسان كما قال المولى تبارك وتعالى: (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ) [الأنبياء: 37]. وقال: (وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا) [الإسراء: 11]. وإذا لم يعمل الداعية على ضبط نفسه، وإلجامها بلجام الشرع دفعته إلى الاستعجال غالبا.
وأما عن البيئة التي نشأ فيها: فقد ينشأ المرء في بيئة يغلب عليها التسرع وعدم التثبت، والعجلة في اتخاذ القرارات والمواقف، والمرء في صغره يتأثر أيما تأثُّر، وينطبع في ذهنه ومخيلته هذا السلوك، ويصبح سمتًا لازمًا له طوال حياته، لذلك قالوا قديمًا: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الكذب على الصغير عندما رأى الأنصارية تنادي على ولدها لتعطيه؛ لأن ذلك سيؤثر سلبًا على الطفل الصغير، فينشأ معتادًا على الكذب وأجوائه.
2- الحماس الزائد، والعاطفة غير الراشدة: مثل هذه الأمور إن لم تكن موزونة بميزان الشرع كانت ضارة على صاحبها؛ لأنها تسلبه الحكمة والإدراك، وتجعله أهوج كثير الخطأ، وربما أدت إلى أعمال تؤذي أكثر مما تفيد، وتضر أكثر مما تنفع، لذا كان مثل هذا التوجيه: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) [الروم: 60].
3- طبيعة العصر: قد تكون طبيعة العصر هي الباعث على الاستعجال، إذ إننا نعيش في عصر يمض بسرعة ويتحرك فيه كل شيء بسرعة، فالإنسان يكون هنا وبعد ساعات يكون في أقصى أطراف الأرض، بسبب التقدم في وسائل المواصلات، والإنسان يضع أساس بيت اليوم ويسكنه غدا بسبب التمكن من وسائل العمارة الحديثة، وقس على ذلك أشياء كثيرة في حياة الإنسان، فلعل ذلك مما يحمل بعض العاملين على الاستعجال لمواكبة ظروف العصر و التمشي معه.
4- شيوع المنكرات مع الجهل بأسلوب تغييرها: واجب المسلم حين يرى منكرا أن يعمل على تغييره وإزالته، قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران: 104]. وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ –رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا)(2).
بيد أنه ليس كل منكر تجب إزالته أو تغييره على الفور، وإنما ذلك مشروط بألا يؤدى إلى منكر أكبر منه، فإن أدى إلى منكر أكبر منه وجب التوقف بشأنه، مع الكراهة القلبية له، ومع مقاطعته، ومع البحث عن أنجع وأنجح الوسائل لإزالته، والأخذ بها، والعزم الصادق على الوقوف في أول الصف حين تتاح فرصة التغيير.
5- العجز عن تحمل المشاق، ومتاعب الطريق: بعض الدعاة يملك جرأة وشجاعة وحماسا لعمل وقتي، لكنه لا يملك القدرة على تحمل مشاقّ ومتاعب الطريق لزمن طويل، مع أن الرجولة الحقة هي التي يكون معها صبر، وجلد، وتحمل، ومثابرة، وجد، واجتهاد حتى تنتهي الحياة. لذلك تراه دائماً مستعجلاً ليجنب نفسه المشاق و المتاعب، وإن تزرَّع بغير ذلك. وقد أفرزت الحركة الإسلامية في العصر الحاضر صنفاً من هذا، عجز عن التحمل والاستمرار فاستعجل وانتهي، وصنفاً آخر أوذي في الله عشرات السنين فصبر، وتحمل واحتسب لأن الظروف غير ملائمة، و الفرص غير مواتية، و العواقب غير محمودة و المقدمات ناقصة أو قاصرة، وكانت العاقبة أن وفقهم الله وأعانهم فثبتت أقدام على الطريق ولا تزال.
6- الانبهار والاغترار بشخصية المتكلِّم، والالتفات لسمته ودَلِّهِ الظاهر، وترك تقييم الكلام وزنته وفحصه: فالناس من طبائعها تصديق ذوي الهيئات التي تدل على الصلاح، والثقة فيما يقولون، وقد لا يدركون أن النفوس محتقنة، والثارات قديمة بين المتكلِّم والمتكلَّم فيه، وأيضًا قد يدرون طبيعة كلام الأقران في بعضهم البعض.
7- عدم وجود منهج يمتص الطاقات، ويخفف من حدتها: نفس الإنسان التي بين جنبيه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل. ولعل ذلك هو السر في أن الإسلام غمر المسلم ببرنامج عمل في اليوم و الليلة، وفي الأسبوع وفي الشهر و في السنة وفي العمر كله، بحيث إذا حافظ عليه كانت خطوته دقيقة، وكانت جهوده مثمرة، قال الله تعالى: (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) [الشرح: 7].
8- الاندفاعُ والانفعال، فقد يؤمن البعضُ بفكرةٍ ما، أو بعدلِ قضيةٍ مُعينة، فيدفعه ذلك للعجلة في السير إلى تحقيقها على أرض الواقع، غافلا عن السنن الكونية، والإعداد السابق لتقبل المجتمع لما يؤمن به ويعتقده إن كان صوابا.
9- العمل بعيدا عن ذوي الخبرة والتجربة: الإنسان يولد ولا علم له بشيء في هذه الحياة كما قال سبحانه: (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [النحل: 78]. ثم يبدأ التعلم من الكتب وبواسطة التجربة، و الممارسة، وبكل طريق يستطيع من خلاله أن يحصل العلم النافع الجاد المثمر.
يقرأ البعض أو يتصور معنى معينا، ويسعى لتطبيقه على المجتمع أو على نفسه؛ ولكنه لا يعلم أنَّ هذا التصور يحتاج إلى إعداد مناط معين يتكيَّف معه ويعيش فيه، فقيام الأخلاق والمجتمع الإسلامي يحتاج إلى نفوس طيبة مزكاة، تربَّتْ على معاني الانقياد للشَّرع.
والداعية الواعي، ينتفع بخبرات وتجارب من سبقوه على الطريق؛ ليوفر على نفسه الجهد، والوقت والتكاليف، أما إذا شمخ بأنفه، ونأي بنفسه، وبدأ العمل بعيدا عن ذوى الخبرة والتجربة فستكون له أخطاء جسيمة، وربما مميتة قاتلة، تصرعه من الجولة الأولى.
10- الغفلة عن سنن الله فـي الكون، وفـي النفس، وفـي التشريع:
من سنن الله فـي الكون: خلق السموات والأرض في ستة أيام، وخلق الإنسان والحيوان والنبات على مراحل، مع أنه جل وعلا قادر على خلق كل ذلك وغيره بقوله "كن".
ومن سنن الله فـي النفس: أنها لا تضحي ولا تبذل ولا تعطى إلا إذا عولجت من داخلها، واقتلعت منها كل الحظوظ، وأدركت قيمة وفائدة التضحية والبذل والعطاء (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) [الشمس: 9، 10]. وذلك لا يتم بسهولة ويسر، وإنما لابد له من جهد ووقت وتكاليف.
ومن سنن الله فـي التشريع: أن الخمر حرمت على مراحل وكذلك غيرها.
إذا نسي الداعية هذه السنن كانت السرعة والعجلة، أما حين تظل ماثلة أمام عينيه، حاضرة في ذهنه وفؤاده، فإنها تهديء من نفسه، وتضبط حركته، وتبصره بموضع قدميه.
11- الغفلة عن سنة الله مع العصاة و المكذبين: من سنة الله مع العصاة و المكذبين، الإمهال، وعدم الاستعجال، قال ربنا تعالى وتقدس: (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ) [الأعراف: 182، 183]. وقال سبحانه: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ) [الأنفال: 59].
وإذا غفل الداعية عن هذه السنن استعجل قائلاً: نناجزهم قبل أن يستفحل شأنهم، وقبل أن يمسكوا بزمام الأمور، فتستحيل إزاحتهم بعد ذلك من طريق الناس.
12- الاغترار ببريق الألفاظ: فقد يقرع أذن الداعية طائفة من الألفاظ المعسولة، والعبارات الخلابة، وإذا به يغتر بها، فيحسبها ذهبًا وهي تراب، فإذا ما أصغى السمع وحرص على مثل هذه الألفاظ وعلى الاستزادة منها، كانت هلكته من حيث يظن النجاة والنفع، فيتعجل في الحكم على أمور أو فعل أشياء نهى الله عنها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو أنهم على شيء.
13- صحبة نفر من ذوي العجلة، وعدم التأني: المرء على دين خليله، والصاحب ساحب، والطباع سرّاقة، وكلما كان المرء ضعيف الشخصية كان إمعة في سلوكه، فيحاكي ويقلد بلا روية ولا بصيرة، والطبع يعدى، وإذا لم يحسن المسلم اختيار صاحبه، فإنه يقتدي به لا محالة في ما يعتنق وفي كل ما يسلك - سيما إذا كان هذا الصاحب قوى الشخصية -.
14- الولاء والبراء للمشايخ وغيرهم فـي المجال الدعوي: بحيث لا يمكن مراجعة قراراتهم وتصنيفاتهم الدعوية، لهذا الداعية أو هذا الخطيب، فيكون الدليل والحجة عند كثيرين: هذا ما قاله الشيخ فلان. أو هذا ما ذهب إليه.
وهذا الأمر من أكثر أسباب شيوع حالة التنافر والتجاذب بين العاملين في مجال الدعوة، فكم من داعية أو خطيب وأدته الشائعات، وقتلته الكلمات، وقُضي على علمه وخيره، بسبب الوشايات والشائعات والتسرع في الحكم عليه.
15- الجهل بأساليب التثبت؛ فقد يجهل الداعية أساليب وطرق التثبت، فيعجل ويتسرع في إصدار القرارات أو يحاكي المتعجلين، ذلك أن للتثبت العديد من الوسائل والطرق؛ منها:
أولا: رد الأمر إلى الله ورسوله، وإلى أولي العلم وأهل الذكر، كما قال تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [النساء: 83].
ثانيا: سؤال صاحب الشأن عن صحة الخبر وبواعثه وأسبابه، ولنا فيما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع حاطب بن أبي بلتعة يوم فتح مكة الأسوة الحسنة في ذلك، حيث لم يبادر بعقوبته رغم جسامة ما اقترافه، إنما أحضره وقرره بما فعل، فأقر حاطب، ثم سأله -صلى الله عليه وسلم- عن دوافعه عن الفعل ومبرراته، ورغم أن المبررات لم تكن مقنعة، إلا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد عذره، ووهب فعلته الرديئة لسالف إحسانه(3).
ثالثا: حسن الإصغاء والاستماع الجيد؛ وذلك بالمراجعة والاستفهام لفحوى الكلام وحقيقة الخبر، فقد يتردد كلام وأخبار لا يراد ظاهرها، ولا تدل على معناها الحقيقي، فعندها يحتاج الكلام للإيضاح، حتى لا ينتج عنه آثار ضارة وربما تكون قاتلة.
رابعا: التجربة والخبرة، والمشاهدة والمقارنة، فمعايشة الأحداث، ومعرفة الأشخاص، تعطي الداعية رصيدًا كبيرًا للتجربة من الفهم والبصيرة بمرامي الكلام وطبائع الأشخاص، والمنافسة بين الأقران، وتمكنه من الحكم ببصيرة على الأخبار والآراء بحق الأشخاص والهيئات.
الداعيــة بيـن الفتــور والاستعجـال:
المقصود من هذا هو تحديد موقع الداعية، أن يكون وسطا بين الفتور والاستعجال، على معنى أنه مع المقدمات كخلية النحل؛ دائب النشاط والحركة، لا يقصر ولا يتوانى لحظة من ليل أو من نهار، ولا يضيع فرصة تتاح له، أما أوانه مع النتائج؛ فهو هاديء متريث متأن غير متهور، لا يستعجل شيئا قبل أوانه وإلا عوقب بحرمانه.
إن ميدان القول غير ميدان الخيال، وميدان العمل غير ميدان القول، يسهل على كثيرين أن يتخيلوا، ولكن ليس كل خيال يدور بالبال يستطاع تصويره أقوالا باللسان، وإن كثيرين يستطيعون أن يقولوا، ولكن قليلا من هذا الكثير يثبت عند العمل.
رَبِّ وَا مُعْتَصِمَاهُ انْطَلَقَتْ مِـلْءَ أَفْوَاهِ السَّبَايَا اليُتَّمِ
لاَمَسَتْ أَسْمَاعَهُمْ لَكِنَّهَا لَـمْ تُلاَمِسْ نَخْوَةَ الْمُعْتَصِمِ
ذكر الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله -: إن الأمة الخاملة صفرٌ من الأصفار، لكن إن بعث الله لها مؤمنًا صادق الإيمان داعيًا إلى الله، صار صفُّ الأصفار مع الواحد مائةَ مليون، والتاريخ مليء بالشواهد على ما أقول.
على الدعاة إلى الله -عز وجل- أن يبذلوا جهدهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يستعجلوا جني ثمار ما بذلوه من الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الله -تبارك وتعالى- أكثر على نبيه -صلى الله عليه وسلم- من الأمر بالصبر، والنهي عن الاستعجال قال الله: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ) [الأحقاف: 35]، فعليك أيها الداعية أن تغرس وتحرث، وأن تترك الإنبات لله -عز وجل-: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) [القصص: 56](4).
فما أجدر رواك الصبيح أن تحصِّل وراءه الرأي الصحيح.
حتى تصادف أُترجًّا يطيب معًا. . . حملًا ونَورًا فطاب العود والورق
فما أقبح المرء أن يكون حسن جسمه باعتبار قبح نفسه جنة يعمرها بوم، كما قال حكيم لجاهل صبيح الوجه: أما البيت فحسنٌ وأما ساكنه فرديءٌ.
فكن أيها الأخ عالمًا، وبعلمك عاملًا، تكن من أولياء الله الذين (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) [يونس: 62]، واحذر الشيطان أن يسبيك، ويغريك بأعراض الدنيا وزخارفها، فيجعلك من أوليائه ويخوفك بوساوسه، كما قال تعالى: (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 175].
ولا يخدعنك عن طلب ذلك وإدراكه (الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [الأعراف: 45].
فقد وصفهم الله تعالى بالصمم والعمى إذ قال: (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ) [هود: 20].
ثم ذمهم بقوله: (أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) [هود: 21].
ثم فرق بينهم وبين من ضادهم فقال: (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) [هود: 24].
فمن عمل لآخرته بورك في كيله ووزنه، وحصل له منه زاد الأبد كما قال تعالى: (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا) [الإسراء: 19].
ومن عمل للدنيا خاب سعيه، وبطل عمله كما قال الله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [هود: 15- 16].
قيل: لا يستطع الوصول من ضيع الأصول.
فمن شغله الفرض عن الفضل فمعذور، ومن شغله الفضل عن الفرض فمغرور(5).
---
(1) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (48).
(2) البخاري (2493).
(3) أخرج البخاري (3007)، ومسلم (2494/161) من حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ، وَالمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، قَالَ: (انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً، وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا)، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا أَخْرِجِي الكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ )، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا، وَلاَ رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ صَدَقَكُمْ)، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، قَالَ: " إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) [الممتحنة: 1].
(4) انظر غير مأمور: آفة الاستعجال: للشيخ حسن عبدالعال محمود، والعجلة: د. أمين بن عبدالله الشقاوي، والأناة: د. محمد بن لطفي الصباغ، والاستيعاب والاقتباس في الدعوة: د/عمر بادحدح، ولكنكم قوم تستعجلون: إيهاب إبراهيم.
(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني (ص: 60).
- التفاصيل
- كتب بواسطة: اللجنة العلمية
- المجموعة: عدد جمادى الأولى 1437هـ
- الزيارات: 36407
من واحة الشعر الدعوي

كُنْ قَابِلَ الْعُذْرِ، وَاغْفِرْ زَلَّةَ النَّاسِ وَلَا تُطِعْ يَا لَبِيباً أَمْرَ وَسْوَاسِ
فَاللهُ يَكْرَهُ جَبَّاراً يُشَارِكُهُ وَيَكْرَهُ اللهُ عَبْداً قَلْبُهُ قَاسِي
هَلَّا تَذَكَّرْتَ يَوْماً، أَنْتَ مُدْرِكُهُ يَوْماً سَتُخْرِجُ فِيهِ كُلَّ أَنْفَاسِ
يَوْمَ الرَّحِيلِ عَنِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا يَوْمَ الْوَدَاعِ شَدِيدَ الْبَطْشِ وَالْبَاسِ
وَيَوْمَ وَضْعِكَ فِي الْقَبْرِ الْمُخِيفِ وَقَدْ رَدُّوا التُّرَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَبِالْفَاسِ
وَيَوْمَ يَبْعَثُنَا، وَالْأَرْضُ هَائِجَةٌ وَالشَّمْسُ مُحْرِقَةٌ، تَدْنُو مِنَ الرَّاسِ
وَالنَّاسُ فِي مُنْتَهَى جُوعٍ، وَفِي ظَمَإٍ وَفِي شَقَاءٍ، وَفِي هَمٍّ وَإِفْلَاسِ
يَفِرُّ كُلُّ امْرِئٍ مِنْ غَيْرِهِ فَرَقاً هَلْ أَنْتَ ذَاكِرُ هَذَا الْيَوْمِ أَمْ نَاسِي؟!
سَيُرْسِلُ اللهُ أَمْلَاكاً مُنَادِيَةً هَيَّا تَعَالَوْا لِرَبٍّ مُطْعِمٍ كَاسِي
هَيَّا تَعَالَوْا إِلَى فَوْزٍ وَمَغْفِرَةٍ هَيَّا تَعَالَوْا إِلى بِشْرٍ وَإِينَاسِ
أَيْنَ الذِينَ عَلَى الرَّحْمَنِ أَجْرُهُمُ فَلَا يَقُومُ سِوَى الْعَافِي عَنِ النَّاسِ
- التفاصيل
- كتب بواسطة: اللجنة العلمية
- المجموعة: عدد جمادى الأولى 1437هـ
- الزيارات: 11220
السلسلة من إعداد اللحنة العملية
بجماعة أنصار السنة المحمدية - فرع بلبيس
إشراف ومراجعة
فضيلة الشيخ د/ صبري عبد المجيد -حفظة الله-
وفضيلة الشيخ / أحمد سليمان -حفظه الله-
والسلسلة دورية تصدر مطلع الشهري الهجري بإذن الله تعالى
والعدد الخامس به الموضوعات التالية:
الافتتاحية مقال بعنوان: أهمية الأخلاق في حياة الدعاة للشيخ / صالح حسون -حفظه الله-
الخطب المنبرية:
قطوف من بستان الواعظين:
قطوف من بستان الواعظين - الأساليب النبوية في الدعوة والوعظ والتربية والتعليم ومعالجة الأخطاء
قطوف من بستان الواعظين من آفات الدعاة الاستعجال
قطوف من بستان الواعظين - من واحة الشعر الدعوي
لتحميل العدد بصيغة "بي دي إف" اضغط على الصورة التالية