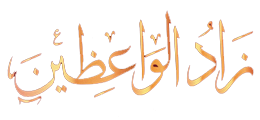عدد جمادى الأولى 1437هـ
- التفاصيل
- كتب بواسطة: الشيخ صالح حسون
- المجموعة: عدد جمادى الأولى 1437هـ
- الزيارات: 10732
أهمية الأخلاق في حياة الدعاة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعد
فإن الدعوة إلى الله تعالى رسالةٌ عظيمةٌ وشرفٌ كبيرٌ اختص الله به من شاء من عباده الذين حملوا شرف هذه المهمة، وقاموا بها على منهج الأنبياء والرسل الكرام - عليهم أفضل الصلاة والسلام -، فهم يجتهدون في تبليغ دين الله تعالى للآخرين في كل زمانٍ وأي مكان تحقيقاً لقوله عز وجل: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } (يوسف: 108 ).
ولا يكتمل هذا الشرف إلا بأوصاف طيبة وأخلاق حسنة تزيد من مكانة الدعاة وترفع من شأنهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى
فالخلق الحسن من أجمل ما يتحلى به الدعاة، وهو أقصر طريق لقلوب الناس، بل إن شئت هو في نفسه دعوة، وقد وصف الله تعالى به نبيه -صلى الله عليه وسلم- فقال: { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ }(القلم: 4).
وقد جُمع حسن الخلق في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} (الأعراف: 199).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال -صلى الله عليه وسلم-: " وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ " وَهُوَ حَقُّ النَّاسِ. وَجِمَاعُ الْخُلُقِ الْحَسَنِ مَعَ النَّاسِ: أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَك بِالسَّلَامِ وَالْإِكْرَامِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالزِّيَارَةِ لَهُ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَك مِنْ التَّعْلِيمِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْمَالِ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَك فِي دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ. وَبَعْضُ هَذَا وَاجِبٌ وَبَعْضُهُ مُسْتَحَبٌّ. وَأَمَّا الْخُلُقُ الْعَظِيمُ الَّذِي وَصَفَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- فَهُوَ الدِّينُ الْجَامِعُ لِجَمِيعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مُطْلَقًا هَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ كَمَا {قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ} وَحَقِيقَتُهُ الْمُبَادَرَةُ إلَى امْتِثَالِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِطِيبِ نَفْسٍ وَانْشِرَاحِ صَدْرٍ. وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي وَصِيَّةِ اللَّهِ فَهُوَ أَنَّ اسْمَ تَقْوَى اللَّهِ يَجْمَعُ فِعْلَ كُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إيجَابًا وَاسْتِحْبَابًا وَمَا نَهَى عَنْهُ تَحْرِيمًا وَتَنْزِيهًا وَهَذَا يَجْمَعُ حُقُوقَ اللَّهِ وَحُقُوقَ الْعِبَادِ. لَكِنْ لَمَّا كَانَ تَارَةً يَعْنِي بِالتَّقْوَى خَشْيَةَ الْعَذَابِ الْمُقْتَضِيَةَ لِلِانْكِفَافِ عَنْ الْمَحَارِمِ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ: {قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. قِيلَ: وَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ قَالَ: الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ} . وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- {أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا} فَجَعَلَ كَمَالَ الْإِيمَانِ فِي كَمَالِ حُسْنِ الْخُلُقِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِيمَانَ كُلَّهُ تَقْوَى اللَّهِ. (1).
وقال ابن القيم رحمه الله: (حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل) (2).
والخلق الحسن من العوامل المهمة في جذب الناس إلى الداعية وتأثرهم به وقبولهم لدعوته -إضافة إلى أجره في الآخرة-، فالناس مفطورون على محبة الفضائل والانجذاب إليها، والنفور من القبائح والابتعاد عنها، والدعية إلى الله أحوج ما يكون إلى التخلق والاتصاف بالأمور المحببة إلى قلوب الناس، فضلا عن أنها من واجبات المسلم.
قال أبو حاتم البستي رحمه الله: الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق، لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة
كلها وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها (3).
وإني لأتعجب من بعض الأدعياء حينما يتصفون بصفات السوء كيف يقبل الناسُ منهم نصحًا، فالناس إذا لاحظوا من الداعية سوءا في أخلاقه نفروا من دعوته، خوفا من تضررهم بأخلاقه السيئة، وقد يميلون إلى تفضيل أهل الفسق والضلال ومجالستهم، إذا آنسوا منهم حسنا في الخلق ورفقا في المعاملة، ولعل السنوات الأخيرة التي عايشناها ولا زلنا خير شاهد على هذا
قال الفضيل بن عياض: " إذا خالطت فخالط حسن الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى خير، وصاحبه منه في راحة، ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء، ولأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله، وخفَّ على الناس وأحبوه وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. "(4)
وحسن الخلق يبذل حتى مع الأعداء، فإنه يقلب البغض حبا، ويبدل العداوة بالولاية الحميمة، وقد قال تعالى: { وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } [فصلت: 34]، فَإِذَا حَسُنَتْ أَخْلَاقُ الْإِنْسَانِ كَثُرَ مُصَافُوهُ، وَقَلَّ مُعَادُوهُ، فَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ الصِّعَابُ، وَلَانَتْ لَهُ الْقُلُوبُ الْغِضَابُ، والسيئ الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء (5).
فالله نسأل أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وكتبه
أبو محمد/ صـالح حسـون
---
(1)مجموع فتاوى ابن تيمية 10/ 658-659.
(2)مدارج السالكين 2/ 308.
(3)روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص 64.
(4) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 64).
(5) أدب الدنيا والدين ص 243بتصرف.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: اللجنة العلمية
- المجموعة: عدد جمادى الأولى 1437هـ
- الزيارات: 14341
فضل الغني في شرح آية الكرسي
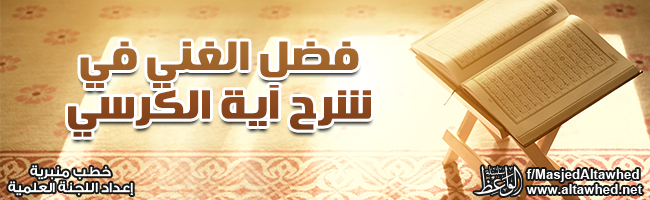
مقدمة فضل آية الكرسي تفسير الآية
مقدمة:
لا شك أن تدبر القرآن من أسمى العلوم التي ينبغي للمسلم الحرص عليه ليمكنه ذلك من فهم معاني القرآن الكريم، إلا أن الشرع عظم شأن بعض آياته وسوره؛ لعظم ما تضمنته من معان، وكل معاني القرآن عظيمة، وإن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي؛ ففيها من المعاني ومن صفات الله وأسمائه وتنزيهه ما لا يحيط به إنسان، ولا يسطره بنان.
ومن تأمل هذه الآية وتدبرها ظهر له من هذه المعاني ما يُعرّفه بقدر هذه الآية، وفضلها وعلوّ منزلتها، فحريّ بكل مسلم أن يحفظها، وأن يعي تفسيرها؛ ليكون له عند الله الثواب العظيم، والأجر الجزيل. (1)
فضل آية الكرسي:
هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات.(2)
قال شيخ الإسلام: وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ وَاحِدَةٌ تَضَمَّنَتْ مَا تَضَمَّنَتْهُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ. (3)
قال القرطبي -رحمه الله-: هَذِهِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ وَأَعْظَمُ آيَةٍ، وَنَزَلَتْ لَيْلًا وَدَعَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، زَيْدًا فَكَتَبَهَا. (4)
ومما يبين فضل هذه الآية ما يأتي:
1- أنها حَوَت اسم الله الأعظم، فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: (إِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ فِي ثَلَاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطَهَ) قَالَ الْقَاسِمُ بن محمد -رحمه الله-: (فَالْتَمَسْتُه فإذا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ). (5)
2- آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، والدليل حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-،: (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ ) قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ ) قَالَ: قُلْتُ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: (وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ). (6) أي ليكن العلم هنيئا لك. وهذا دليل على كثرة علمه.
3- آية الكرسي يحفظ الله بها عبده من الشيطان بالليل والنهار، والدليل حديث ابن أبي بن كعب، أَنَّ أَبَاهُ أبي بن كعب -رضي الله عنه-، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جُرْنٌ فِيهِ تَمْرٌ، وَكَانَ أُبَيٌّ يَتَعَاهَدُهُ فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ تُشْبِهُ الْغُلَامَ الْمُحْتَلِمَ، قَالَ: فَسَلَّمَتْ فَرَدَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ، أَجِنٌّ أَمْ إِنْسٌ؟ قَالَ: جِنٌّ، قَالَ: فَنَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ، فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمتِ الْجِنُّ، مَا فِيهِمْ أَشَدُّ مِنِّي، قَالَ لَهُ أُبَيٌّ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ، قَالَ أُبَيٌّ: فَمَا الَّذِي يُجِيرُنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَا قَرَأْتَهَا غُدْوَةً أُجِرْتَ مِنَّا حَتَّى تُمْسِيَ، وَإِذَا قَرَأْتَهَا حِينَ تُمْسِي أُجِرْتَ مِنَّا حَتَّى تُصْبِحَ، قَالَ أُبَيٌّ فَغَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (صَدَقَ الْخَبِيثُ). (7)
لذلك قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: إذا قرأها الإنسانُ عند الأحوال الشيطانية بصدقٍ أبطلتْها. (8)
4- آية الكرسي يحفظ الله بها بيوت المسلمين من كيد الشياطين، والدليل حديث أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِيءُ الغُولُ(9) فَتَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ: فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: " فَاذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، " قَالَ: فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ)؟ قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ: فَقَالَ: (كَذَبَتْ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ)، قَالَ: فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ)؟ قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ. فَقَالَ: (كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ)، فَأَخَذَهَا. فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِكِ حَتَّى أَذْهَبَ بِكِ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-،: فَقَالَتْ: إِنِّي ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا، آيَةَ الكُرْسِيِّ، اقْرَأْهَا فِي بَيْتِكَ فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ)؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ، قَالَ: (صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ). (10)
5- آية الكرسي يحفظ الله بها عبده من الشيطان عند نومه: والدليل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ،. . . وفيه: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-،: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: (مَا هِيَ)، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ}، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-،: (أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ)، قَالَ: لاَ، قَالَ: (ذَاكَ شَيْطَانٌ). (11)
6- من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت: والدليل حديث أَبِي أُمَامَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-،: (مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ). (12)
- تفسير الآية
هذه الآية مشتملة على عشرة محاور التي هي أعظم أصول الإسلام وهي:
- المحور الأول: تقرير انفراد الله جل وعلا بالألوهية دون سواه
وهذا في الجملة الأولى من الآية في قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}
فَقَوْلُهُ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ} إِخْبَارٌ بِأَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْإِلَهِيَّةِ لِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ. (13)
فالله: هو المألوه المعبود، ذو الألوهية والعبودية على جميع خلقه. وهَذَا الاسم أعظمُ أَسمَاء الله عز وَجل التِّسْعَة وَالتسْعين لِأَنَّهُ دَال على الذَّات الجامعة لصفات الإلهية كلهَا حَتَّى لَا يشذ مِنْهَا شَيْء، وَلِأَنَّهُ أخص الْأَسْمَاء إِذْ لَا يُطلقهُ أحد على غَيره لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا. (14)
{لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} كلمة التوحيد التي تتضمن النفي والإثبات، نافية جميع ما يعبد من دون الله، مثبتة العبادة لله وحده، فلا معبود بحق إلا الله عز وجل.
فهذه الجملة تنفي نفيا قاطعا الألوهية الحقة إلا لمن يستحقها، وهو رب العالمين. { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [الحج: 62]
{لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ} كَلِمَةٌ قَامَتْ بِهَا الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، وَخُلِقَتْ لِأَجْلِهَا جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَبِهَا أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، وَشَرَعَ شَرَائِعَهُ، وَلِأَجْلِهَا نُصِبَتِ الْمَوَازِينُ، وَوُضِعَتِ الدَّوَاوِينُ، وَقَامَ سُوقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَبِهَا انْقَسَمَتِ الْخَلِيقَةُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارِ وَالْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ، فَهِيَ مَنْشَأُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَهِيَ الْحَقُّ الَّذِي خُلِقَتْ لَهُ الْخَلِيقَةُ، وَعَنْهَا وَعَنْ حُقُوقِهَا السُّؤَالُ وَالْحِسَابُ، وَعَلَيْهَا يَقَعُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَعَلَيْهَا نُصِبَتِ الْقِبْلَةُ، وَعَلَيْهَا أُسِّسَتِ الْمِلَّةُ، وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، وَهِيَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، فَهِيَ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ، وَمِفْتَاحُ دَارِ السَّلَامِ، وَعَنْهَا يُسْأَلُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، فَلَا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَتَيْنِ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ وَمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ؟.
فَجَوَابُ الْأُولَى بِتَحْقِيقِ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " مَعْرِفَةً وَإِقْرَارًا وَعَمَلًا.
وَجَوَابُ الثَّانِيَةِ بِتَحْقِيقِ " أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " مَعْرِفَةً وَإِقْرَارًا وَانْقِيَادًا وَطَاعَةً. زاد المعاد لابن القيم (1/ 36)
المحور الثاني: إثبات جميع الكمالات لله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله
وذلك من خلال إثبات اسمي ( الحي القيوم ) وصفتي الحياة والقيومية
كان ابن عباس -رضي الله عنهما-، يقول: أعظم أسماء الله عزّ وجلّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. (15)
قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: عَلَى هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ مَدَارُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى كُلِّهَا، وَإِلَيْهِمَا تَرْجِعُ مَعَانِيهَا. فَإِنَّ الْحَيَاةَ مُسْتَلْزِمَةٌ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، ولَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا صِفَةٌ مِنْهَا إِلَّا لِضَعْفِ الْحَيَاةِ، فَإِذَا كَانَتْ حَيَاتُهُ - تَعَالَى - أَكْمَلَ حَيَاةٍ وَأَتَمَّهَا، اسْتَلْزَمَ إِثْبَاتُهَا إِثْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ يُضَادُّ نَفْيُهُ كَمَالَ الْحَيَاةِ.
وَأَمَّا"الْقَيُّومُ"فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ كَمَالَ غِنَاهُ وَكَمَالَ قُدْرَتِهِ، فَإِنَّهُ الْقويمُ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُقِيمُ لِغَيْرِهِ، فَلَا قِيَامَ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِإِقَامَتِهِ. فَانْتَظَمَ هَذَانِ الِاسْمَانِ صِفَاتِ الْكَمَالِ أَتَمَّ انْتِظَامٍ. (16)
قال تعالى مخاطبا نبيه -صلى الله عليه وسلم-، { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ} [الفرقان: 58] وقال سبحانه{ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [القصص: 88]
وقال تعالى { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 26، 27]
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، كَانَ يَقُولُ: ( أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ). (17)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قال للناس عند وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،: أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم-، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ. (18)
والقيوم: كامل القيومية، وله معنيان:
1 - هو الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه ودليله قوله تعالى: {وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}.
2 - وهو الذي قامت به السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات، ودليله قوله تعالى: {أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ}. (19)
وَاقْتِرَانُ اسم القيوم باسم الْحَيِّ يَسْتَلْزِمُ سَائِرَ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَيَدُلُّ عَلَى بَقَائِهَا وَدَوَامِهَا، وَانْتِفَاءِ النَّقْصِ وَالْعَدَمِ عَنْهَا أَزَلًا وَأَبَدًا. (20)
المحور الثالث: نفي جميع صفات النقص عن الله وإثبات كمال ضدها له سبحانه.
وذلك متمثل في قوله تعالى{لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ}
فهاتان صفتان سلبيتان، منفيتان عن الله لإثبات كمال ضدهما وهما كمال حياته سبحانه وقيوميته، وهذا مسلك أهل السنة مع جميع الصفات السلبية التي وردت في القرآن والسنة.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّفْيَ لَيْسَ فِيهِ مَدْحٌ وَلَا كَمَالٌ إلَّا إذَا تَضَمَّنَ إثْبَاتًا، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ النَّفْيِ لَيْسَ فِيهِ مَدْحٌ وَلَا كَمَالٌ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَحْضَ عَدَمٌ مَحْضٌ؛ وَالْعَدَمُ الْمَحْضُ لَيْسَ بِشَيْءِ.
فَنَفْيُ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ: يَتَضَمَّنُ كَمَالَ الْحَيَاةِ وَالْقِيَامِ؛ فَهُوَ مُبَيِّنٌ لِكَمَالِ أَنَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. (21)
وَمعنى السِّنَة: النُّعَاسُ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ. وَالنُّعَاسُ مَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ فَإِذَا صَارَ فِي الْقَلْبِ صَارَ نَوْمًا. (22)
فَقَوْلُهُ: {لَا تَأْخُذُهُ} أَيْ: لَا تَغْلِبُهُ سِنَةٌ وَهِيَ الْوَسَنُ وَالنُّعَاسُ وَلِهَذَا قَالَ: {وَلا نَوْمٌ} لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنَ السِّنَةِ. (23)
والإنسان وغيره من المخلوقات محتاج إلى الله في يقظته ونومه، لكن الخالق المتصف بالقيومية وتلك الصفة تنافي السنة والنوم، لأنه - عز وجل - لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري -رضي الله عنه-، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: (( إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةِ النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ )). (24) فالله مُنَزَّهٌ عَنْ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَاقِضُ كَمَالَ الْحَيَاةِ والقيومية فَإِنَّ النَّوْمَ أَخُو الْمَوْتِ وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ كَمَا لَا يَمُوتُونَ. (25)
المحور الرابع كمال ملك الله تعالى وسلطانه وتقرير ذلك في قوله {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ }.
واللام في قوله ( له ) للملك فهو سبحانه يملك كل شيء ملكا تاما، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم، وكل ما حقه التأخير إذا تقدم فهو يفيد الحصر، فبذلك يكون سبب تقديم الخبر حصر ملكية السماوات والأرض وما فيهن لله - عز وجل - دون سواه، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته. (26)
ففي هذه الآية إِخْبَارٌ بِأَنَّ الْجَمِيعَ عَبِيدُهُ وَفِي مُلْكِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ كَقَوْلِهِ: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا * وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}. (27)
ويتفرع على كون الملك لله ألا نتصرف في ملكه إلا بما يرضاه. (28)
المحور الخامس بيان عظمة الله تعالى وكبريائه وقهره لجميع خلقه وتقرير ذلك في قوله تعالى{ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ} والمعنى أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله تعالى، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن. (29)
وفِي هَذَا الِاسْتِفْهَامِ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ عِبَادِهِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْفَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ بِشَفَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَالتَّقْرِيعُ وَالتَّوْبِيخُ لَهُ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ. (30)
وهذا كَقَوْلِهِ تعالى: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النَّجْمِ: 26] وَكَقَوْلِهِ: {وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى} [الْأَنْبِيَاءِ: 28] وَهَذَا مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ لَا يَتَجَاسَرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ. (31)
فَنَفْيُ الشَّفَاعَةِ بِدُونِ إذْنِهِ مُسْتَلْزِمٌ لِكَمَالِ مُلْكِهِ؛ وغناه عن خلقه، وافتقار الخلائق جميعا له، عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (( يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي )). (32)
وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِالشَّفَاعَةِ إلَيْهِ فَكَانَ إذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ يَقُولُ: {اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ} أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ وَكَانَ مَقْصُودُهُ أَنَّهُمْ يُؤْجَرُونَ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَهُوَ إنَّمَا يَفْعَلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ. (33)
ومعنى الشفاعة: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. (34)
وهي نوعان: 1 - شفاعة مثبتة. 2 - وشفاعة منفية.
أما المثبتة: فهي التي تطلب من الله، ولا تكون إلا لأهل التوحيد وهي مقيدة بأمرين:
1 - إذن الله للشافع أن يشفع. 2 - رضاه عن المشفوع له. (35)
لذلك فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-، صاحب المقام المحمود الذي سيحمده عليه جميع الخلائق في عر صات القيامة عندما يطلب الخلائق منه أن يشفع لهم لبدء الحساب، فيخرُّ تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتح الله عليه بها ويستأذن ربه في الشفاعة فيأذن له.
وأخبر -صلى الله عليه وسلم-، أنه قد ادخر دعوته للشفاعة يوم القيامة، كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-،: (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا). (36)
والشفاعة المنفية: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 254]. ونردُّ بهذا على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة. (37)
المحور السادس إِحَاطَة عِلْمِ الله تعالى بِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ وَذلك في قَوْله تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ}.
إنه العلم المحيط الشامل الكامل يقول الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7] معهم أينما كانوا بعلمه، بقدرته، بإرادته، بإحاطته، بقهره.
قال ابن كثير -رحمه الله-: وفي هذا دَلِيلٌ عَلَى إِحَاطَةِ عِلْمِهِ بِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ: مَاضِيهَا وَحَاضِرِهَا وَمُسْتَقْبَلِهَا كَقَوْلِهِ إِخْبَارًا عَنِ الْمَلَائِكَةِ: {وَمَا نَتَنزلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}. (38)
وعِلمُ الله - جل وعلا - علم محيط بكل شيء فهو العليم الذي أحاط علمه بالعلم العلوي والسفلي، لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان، قال تعالى {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا} [طه: 98]
وقال تعالى{ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: 12]
فالله - سبحانه وتعالى - يعلم ما كان وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم أحوال المكلفين قبل إنشائهم وحين أنشأهم وبعد مماتهم وبعدما يحييهم، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. (39)
وبهذا نستطيع الرد على القدرية الغلاة؛ فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. (40)
المحور السابع عجز العباد عن أن يحيطوا بشيء من علم الله إلا بمشيئته وَتقرير ذلك في قَوْله: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ}
أَيْ: لَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَى شَيْءٍ إلا بِمَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ إِلَّا بِمَا أَطْلَعَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ: {وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طَهَ: 110]. (41)
فلما بيَّن سبحانه قهره لهم بعلمه، بين عجزهم عن كل شيء من علمه إلا ما أفاض عليهم بعلمه فقال: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ}. أي قليل ولا كثير {مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ}. فبان بذلك ما سبقه، لأن من كان شامل العلم ولا يعلم غيره إلا ما علمه كان كامل القدرة، فكان كل شيء في قبضته، فكان منزها عن الكفؤ متعاليا عن كل عجز وجهل، فكان بحيث لا يقدر غيره أن ينطق إلا بإذنه لأنه يسبب له ما يمنعه مما لا يريده. (42)
فَنَفَى أَنْ يَعْلَمَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ لَيْسَ إِلَّا أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ بِالتَّعْلِيمِ، فَهُوَ الْعَالِمُ بِالْمَعْلُومَاتِ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا بِتَعْلِيمِهِ، كَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: {لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [البقرة: 32]
وقال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام (( يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لاَ أَعْلَمُهُ )). (43)
وقال مخاطباً مُعَلِّمَ البشرية -صلى الله عليه وسلم-، { وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113]
وقال سبحانه ممتناً على جميع خلقه{ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [النحل: 78]
وبيَّن سبحانه أنه علَّم الإنسان ما لم يكن يعلم فقال { الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 4، 5]
واختصَّ الله جل وعلا نفسه بعلم بعض الأشياء لم يطلع عليها أحداً من خلقه ليبين لهم عجزهم وعدم قدرتهم على إدراك علم شيء لم يعلمهم إياه، فقال تعالى{ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34]
وكما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: (( فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ)). ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-،: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34] الآيَةَ. (44)
المحور الثامن: عِظمُ المخلوقات يدلُّ على عظمة الخالق وتقرير ذلك في قوله تعالى{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} أي شمل، وأحاط، كرسيه بالسماوات والأرض.
فسبحان الخالق العظيم الذي خلق وأبدع هذه المخلوقات العظيمة التي لا يستطيع العقل تصور قدرها ولا الإحاطة بها فما ظنك بمن خلقها؟! ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه-، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، جَالِسٌ وَحْدَهُ، فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلَقَةِ). (45)
قال الألباني -رحمه الله-: وهذا الحديث صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا. وفيه ردٌّ على من يتأوله بمعنى الملك وسعة السلطان، كما جاء في بعض التفاسير. وما روي عن ابن عباس أنه العلم، فلا يصح إسناده إليه. (46)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قال: لَوْ أن السموات السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ بُسِطْنَ ثُمَّ وُصِلْنَ بَعْضُهُنَّ إِلَى بَعْضٍ مَا كُنَّ فِي سِعَةِ الْكُرْسِيِّ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْحَلْقَةِ فِي الْمَفَازَةِ. (47)
وهذا يدل على كمال عظمة الله وسعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. (48)
المحور التاسع كمال قوة الله وقدرته وأنه منزه عن العجز والتعب وتقرير ذلك في قوله تعالى{وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا} أَيْ لَا يُثْقِلُهُ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ حفظُهما. وهذا دليل على أن السموات، والأرض تحتاج إلى حفظ؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا}؛ ولولا حفظ الله لفسدتا وزالتا؛ لقوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا } [فاطر: 41]
وقال تعالى{وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحج: 65]
تأمل مدى قوة الله وقدرته، هذه القوة والقدرة التي أمسك بها السماء التي مسيرة سمكها خمسمائة عام، أن تزول أو تقع على الأرض، وهي ليست سماء واحدة بل سبع سماوات. . . . حقاً{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: 67]
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ، تَصْدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}. (49)
* فيا مَنْ سلكتَ طريقَ الهداية ثِقْ تماماً أن الذي حفظ السماوات والأرض من الزوال بقدرته، قادر على حفظ عبده من كيد أعدائه: { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ} [الزمر: 36، 37]
* و يا مَنْ سلكت طريق الغواية، وتجرأت على الحرمات، أتدري أنك تعرض نفسك لسخط مِنْ؟ أُحَذِّرُك ونفسي من عذاب الله: {وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ} [البقرة: 165]
المحور العاشر: إثبات العلو لله تعالى بكل أنواعه وتقرير ذلك في قوله تعالى{ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}
{وهو العلي} بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته {العظيم} الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء. (50)
وعلوّ الله عند أهل السنة، والجماعة ينقسم إلى قسمين؛ الأول: علو الذات؛ بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء؛ وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، والعقل، والفطرة؛ وتفصيل هذه الأدلة في كتب العقائد.
والقسم الثاني: علو الصفة: وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه أحد في ذلك؛ وهذا متفق عليه بين فرق الأمة، وإن اختلفوا في تفسير الكمال.
وإثبات العلو يتضمن الرد على الحلولية، وعلى المعطلة النفاة؛ فالحلولية قالوا: إنه ليس بعالٍ؛ بل هو في كل مكان؛ والمعطلة النفاة قالوا: لا يوصف بعلو، ولا سفل، ولا يمين، ولا شمال، ولا اتصال، ولا انفصال. (51)
وهو سبحانه مع علوه على عرشه فوق سماواته، فهو قريب من عباده محيط بهم يرى أعمالهم ويسمع سرهم ونجواهم، لا تخفى عليه خافية من أمرهم.
وأخيرًا: فهذه آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، احفظها، حافظ على تلاوتها صباحا ومساء وعند نومك، تدبر معانيها وما فيها من صفات الله العظيمة وأسمائه الحسنى الكريمة حتى يزداد بذلك إيمانك بالله ويشتد تعظيمك له ولكتابه، ويحفظك الله بها في الدنيا من الشياطين، ويرفع درجتك بها في الآخرة في المهديين.
---
(1) دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم (3/ 1)
(2) تفسير السعدي (ص: 110)
(3) مجموع الفتاوى (17/ 130)
(4) تفسير القرطبي (3/ 268)
(5) رواه ابن ماجه (3856) والحاكم في المستدرك (1/ 684) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 371)
(6) رواه مسلم (810)
(7) رواه النسائي في الكبرى (10730) والحاكم (1/ 749) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/ 188)
(8) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: 170)
(9) (السهوة) بفتح السين المهملة: هي الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء. وقيل: المخدع بين البيتين. وقيل: هو شيء شبيه بالرف. وقيل: بيت صغير كالخزانة الصغيرة.
الغُولُ: أحَدُ الغِيلَان، وَهِيَ جِنْس مِن الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ، كَانَتِ العَرب تَزْعُم أَنَّ الغُول فِي الفَلاة تَتَرَاءَى لِلنَّاسِ فتَتَغَوَّلُ تَغَوُّلًا: أَيْ تَتَلَوّن تلَوُّنا فِي صُوَر شَتَّى، وتَغُولُهم أَيْ تُضِلُّهم عَنِ الطَّرِيقِ وتُهْلِكهم، فَنَفاه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبْطَله بقَوْله (لَا غُولَ). ومعنى قَوْله (لَا غُولَ) لَيْسَ نَفْياً لعَين الغُول ووجُودِه، وَإِنَّمَا فِيهِ إِبْطَالُ زَعْم الْعَرَبِ فِي تَلَوُّنه بالصُّوَر المخْتِلَفة واغْتِيَالِه، فَيَكُونُ المعْنى بِقَوْلِهِ (لَا غُولَ) أنَّها لَا تَسْتَطيع أَنْ تُضِلَّ أحَداً. النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 396)
(10) رواه الترمذي (2880) وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/ 187)
(11) رواه البخاري (2311)
(12) رواه النسائي (9848) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1103)
(13) تفسير ابن كثير (1/ 678)
(14) المقصد الأسنى للغزالي (ص: 61)
(15) تفسير الثعلبي (2/ 230)
(16) شرح الطحاوية (ص: 78)
(17) رواه مسلم (2717)
(18) رواه البخاري (4454)
(19) مجلة البحوث الإسلامية (82/ 97)
(20) شرح الطحاوية (ص: 78)
(21) مجموع الفتاوى (3/35 - 36) باختصار
(22) تفسير القرطبي (3/ 272)
(23) تفسير ابن كثير(1/ 678)
(24) رواه مسلم (179)
(25) مجموع الفتاوى (9/ 181)
(26) مجلة البحوث الإسلامية (82/ 102)
(27) تفسير ابن كثير(1/ 679)
(28) تفسير العثيمين (3/ 258)
(29) تفسير السعدي (ص: 110)
(30) فتح القدير للشوكاني (1/ 311)
(31) تفسير ابن كثير (1/ 679)
(32) رواه مسلم (2577)
(33) مجموع الفتاوى (17/ 109)
(34) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 330)
(35) مجلة البحوث الإسلامية (82/ 106)
(36) رواه البخاري (6304) ومسلم (199)
(37) تفسير العثيمين (3/ 260)
(38) تفسير ابن كثير (1/ 679)
(39) مجلة البحوث الإسلامية (82/ 114)
(40) تفسير العثيمين (3/ 260)
(41) تفسير ابن كثير(1/ 679)
(42) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي(4/ 33)
(43) رواه البخاري (122)
(44) رواه البخاري (50) ومسلم (9)
(45) رواه أبو الشيخ في كتابه العظمة (2/ 649) وأبو نعيم في الحلية (1/ 166) والبيهقي في الأسماء والصفات (862) وصححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (1/ 223)
(46) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 226)
(47) تفسير ابن كثير (1/ 680)
(48) تفسير السعدي (ص: 110)
(49) رواه البخاري (4811) ومسلم (2786)
(50) تفسير السعدي (ص: 110)
(51) تفسير العثيمين (3/ 262)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: اللجنة العلمية
- المجموعة: عدد جمادى الأولى 1437هـ
- الزيارات: 10368
قبسات من مشكاة النبوة

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، بِيَدِي فَقَالَ: (يَا مُعَاذُ)، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يا رسول الله، قَالَ: (إِنِّي أُحِبُّكَ)، قُلْتُ: وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ يا رسول الله، قَالَ: (أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاة؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (( قُلِ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ )).(1)
راوي الحديث:
هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري -رضي الله عنه-، أسلم وعمره ثمان عشرة سنة، وشهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، (أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ).(2)
لذلك اختاره النبي -صلى الله عليه وسلم-، ليكون سفيراً له إلى اليمن ليدعو الناس إلى توحيد الله ويعلمهم أركــان الـدين، وجاء في الأثر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-،: (يأتي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَتْوَةٍ يوم القيامة). (3) أي يحشر يوم القيامة متقدما على العلماء برمية سهم أو حجر. مات -رضي الله عنه-، بناحية الأردن في طاعون عمواس: سنة ثماني عشرة وهو ابن ثلاث وقيل: أربع وقيل ثمان وثلاثين سنة.
شرح الحديث
* قوله -صلى الله عليه وسلم-، لمعاذ -رضي الله عنه- (يَا مُعَاذُ إِنِّي أُحِبُّكَ).
- فيه بيان لما كان عليه -صلى الله عليه وسلم-، من تواضعه وترفقه وحسن تعليمه لأصحابه -رضي الله عنهم-.
قال تعالى في وصف نبيه {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159]
وقال تعالى{ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } [التوبة: 128]
وصدق فيه قول مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ -رضي الله عنه-: بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ. (4)
- وفيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه حال الراعي مع رعيته وكل مَن ولاه الله ولاية، لأن الأصل في علاقة الراعي مع رعيته، الرحمة والعطف والتناصح والتواصل والمحبة، وإلا فسدت حياة الناس ووقع بينهم التنازع والتناحر والتقاتل، فعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: (خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ). (5)
- وفيه تعليم وتوجيه للدعاة إلى الله تعالى من سيد الدعاة -صلى الله عليه وسلم-، أن يقدموا بين يدي دعوتهم ما يدل على محبتهم وحرصهم على المدعو، وهذا أدعى لقبول دعوتهم وأسكن لنفوس المدعوين وأشرح لصدورهم.
قال تعالى{ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } [النحل: 125]
* وفي قول معاذ -رضي الله عنه- (( وأنا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ يا رسول الله )).
- فيه بيان لما كان عليه حال الصحابة -رضي الله عنهم-، من محبة النبي -صلى الله عليه وسلم- محبة صادقة، فهم الذين ضربوا المثل الأعلى في صدق محبتهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإليك هذا المثال، لما أَسَرَ المشركون زيدَ بنَ الدَّثِنَة -رضي الله عنه-، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ. وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ أَبُو سُفْيَانَ ابْن حَرْبٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا زَيْدُ، أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا عِنْدَنَا الْآنَ فِي مَكَانِكَ نَضْرِبُ عُنُقَهُ، وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ آمِنَا؟ قَالَ: وَاَللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا الْآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَة تؤذيه، وأنّى جَالِسٌ فِي أَهْلِي. فقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا. (6)
- وفيه بيان لما يجب على كل مسلم من محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أكثر من النفس والمال والأهل. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ). (7)
وعن عَبْد اللَّهِ بْن هِشَامٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-،: (لاَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-،: (الآنَ يَا عُمَرُ). (8)
- وفيه تقرير لسُنَّةٍ علمناها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبيانها في حديث الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: (إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ). (9)
فإذا أخبر المسلم أخاه أنه يحبه، فيقل له: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. وذلك لما ورد في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-،: (أَعْلَمْتَهُ؟ ) قَالَ: لَا، قَالَ: (أَعْلِمْهُ) قَالَ:
فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. (10)
* وفي قوله: (أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاة؟ ).
- فيه بيان لأسلوب من أساليب الدعوة بأن تكون الدعوة في صيغة سؤال، للفت انتباه السامع ليحضر قلبه ويصغي سمعه فيكون ذلك أدعى لتأثره بما يسمعه وأسرع استجابة.
- واختلف أهل العلم في المقصود بدبر الصلاة في هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الدعاء، فقال بعضهم: المقصود به الدعاء بعد الانتهاء والسلام من الصلاة، وهو قول له حظه من النظر والاستدلال، وعليه جمهور أهل العلم، وقال آخرون منهم ابن تيمية وابن القيم: المقصود به آخر الصلاة قبل السلام، وهو قول قوي تؤيده المرجحات الآتية:
الأول: أن الغالب استعمال كلمة الدبر للجزء من الشيء، فدبر الحيوان جزء منه، وكذلك دبر الصلاة.
الثاني: أن ما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله بعد الصلاة لم ينقل فيه دعاء، وإنما نقل الاستغفار والتهليل والتسبيح، وغيره من الأذكار.
الثالث: أن الدعاء داخل العبادة أفضل من الدعاء خارجها. (11)
* وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: (( قُلِ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي ))
- فيه دليل على ضعف الإنسان وفقره وشدة حاجته لربه جل وعلا، فالموفَّق من وفقه الله، والمخذول من خذَلَه الله عز وجل، لذلك قال تعالى{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} [فاطر: 15]
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (( يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ )). (12)
وهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعلنها صريحة واضحة، أنَّ العباد جميعا في أشدِّ الحاجة إلى توفيق الله وإعانته وتسديده، حتى لا يغترَّ أحدٌ بعده -صلى الله عليه وسلم-، بسعيه وجهده وعمله، فعَنِ البَرَاءِ -رضي الله عنه-، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللَّهِ بن رواحة:
اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا. . . وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا. . . وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا
إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا. . . إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا
يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ. (13)
وعن أَبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ) قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ( لاَ، وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا). (14)
قال الراغب الأصفهاني -رحمه الله-:
يجب أن يعلم كل إنسان أنه لا سبيل لأحد إلى شيء من الفضائل إلا بهداية اللَّه تعالى ورحمته، فهو مبدأ الخيرات ومنتهاها، كما قال تعالى: (أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)). وخاطب الناس فقال: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )). (15)
وقال تعالى{ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 83] وقال سبحانه{ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [البقرة: 64]
تبرأ من حولك وقوتك والجأ إلى حوله وقوته واستعن به، وتوجه إليه واطلب منه. . والزم: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } [الفاتحة: 5]
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رحمه الله-: تَأَمَّلْتُ أَنْفَعَ الدُّعَاءِ فَإِذَا هُوَ سُؤَالُ الْعَوْنِ عَلَى مَرْضَاتِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الْفَاتِحَةِ فِي {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]. (16)
قال الصنعاني -رحمه الله-:
وَفِي إفْرَادِهِ تَعَالَى بِالِاسْتِعَانَةِ فَائِدَتَانِ، فَالْأُولَى أَنَّ الْعَبْدَ عَاجِزٌ عَنْ الِاسْتِقْلَالِ بِنَفْسِهِ فِي الطَّاعَاتِ، وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ لَا مُعِينَ لَهُ عَلَى مَصَالِحِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ إلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَعَانَهُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُعَانُ، وَمَنْ خَذَلَهُ فَهُوَ الْمَخْذُولُ. فَالْعَبْدُ أَحْوَجُ إلَى مَوْلَاهُ فِي طَلَبِ إعَانَتِهِ عَلَى فِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ وَتَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَقْدُورَاتِ. (17)
وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: (( قُلِ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي على ذكرك ))
- هنا سؤال: هل يحتاج الذكر إلى إعانة؟ هل الذكر عملٌ شاق وصعب لهذه الدرجة؟
- فالذكرُ مع سهولته ويسره على كل إنسان صغير وكبير ذكر وأنثى، ومع ما يجلبه من راحة النفوس، وسعة الصدور واطمئنان القلوب، إلا أنك ترى واقع بعض الناس يدل على خلاف ذلك، فتمرُّ الأوقات والساعات والأعمار ثم تجد الحصيلة في غاية الضعف، فما السرُّ في ذلك؟ السرُّ في ذلك ضعف الهمم وقلة الرغبة فيما عند الله، فعلى قدر إقبالك على الله وصدق نيتك وقوة عزيمتك تكون المعونة من الله تعالى
قال ابن القيم -رحمه الله-: المعونة من الله تنزل على الْعباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عَلَيْهِم على حسب ذَلِك فَالله سُبْحَانَهُ أحكم الْحَاكِمين وَأعلم الْعَالمين يضع التَّوْفِيق فِي موَاضعه اللائقة بِهِ والخذلان فِي موَاضعه اللائقة بِهِ هُوَ الْعَلِيم الْحَكِيم، وَمَا أُتِي من أُتِي إِلَّا من قِبَل إِضَاعَة الشُّكْر وإهمال الافتقار وَالدُّعَاء، وَلَا ظفر من ظفر بِمَشِيئَة الله وعونه إِلَّا بقيامه بالشكر وَصدق الافتقار وَالدُّعَاء، وملاك ذَلِك الصَّبْر فَإِنَّهُ من الْإِيمَان بِمَنْزِلَة الرَّأْس من الْجَسَد فَإِذا قطع الرَّأْس فَلَا بَقَاء للجسد. (18)
فالله هو الموفق، الله هو الذي يصطفى ويختار. . فالسير في الطريق إلى الله مبنى على الاصطفاء والاختيار، فاذا اختارك واصطفاك هيأك، قال الله تعالى في حق يونس عليه السلام { فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ } [القلم: 50]
وكم من إنسان شريف النسب أبعده الله، وكم من إنسان وضيع النسب قربه الله وأدناه، وكل ذلك بعلم وحكمة
قال ابن القيم -رحمه الله-: هبّت عواصف الأقدار فِي بيداء الأكوان فتقلب الْوُجُود وَنجم الْخَيْر فَلَمَّا ركدت الرّيح: إِذا أَبُو طَالب غريق فِي لجة الْهَلَاك، وسلمان على سَاحل السَّلامَة، والوليد بن الْمُغيرَة يقدم قومه فِي التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الرّوم، وَالنَّجَاشِي فِي أَرض الْحَبَشَة يَقُول لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك، وبلال يُنَادي الصَّلَاة خير من النّوم، وَأَبُو جهل فِي رقدة الْمُخَالفَة. (19)
سبحانك يا الله يا عليم يا حكيم، قربت سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، وأبعدت أبا جهل القرشي، وأبا طالب عمَّ النبي، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } [الأنبياء: 23]
قال الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رحمه الله-، عَنِ الْقَدَرِ:
مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أشأْ. . . وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ
خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ. . . فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ
عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ. . . وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ. . . وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنْ(20)
- العبد يحتاج إلى ربه في ردِّ كيد عدوه - وهو الشيطان -
فالشيطان لا يتوقف مكره بالإنسان ليلا ولا نهارا، يأتي الإنسان عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه بلا هوادة، ولن يردَّ كيده في نحره إلا مَنْ خلقه ويعلم مكره ووسوسته، لذلك لابد للعبد من اللجوء إلى الله
قال ابن القيم -رحمه الله-: فلا نجاة للعبد من مصائد الشيطان ومكائده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى، والتعرض لأسباب مرضاته، والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذى هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان {إِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42]. (21)
وحكي عَنْ بعض السلف أنه قَالَ لتلميذه: مَا تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قَالَ: أجاهده. قَالَ: فَإِن عاد؟ قَالَ: أجاهده. قَالَ: فَإِن عاد؟ قَالَ: أجاهده. قَالَ: هَذَا يطول، أرأيت إنْ مررتَ بغنمٍ فنبحك كلبُها أَوْ منعك مِن العبور مَا تصنع؟ قَالَ: أكابده وأرده جهدي. قَالَ: هَذَا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يَكُفُه عنك. (22)
- العبد يحتاج إلى أن يسدده الله في جميع أعماله
كم من إنسان يكدّ ويعمل والله عز وجل معرضٌ عنه، بل كلما اجتهد في عمله ازداد من الله بعداً.
كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها {عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً}. لطائف المعارف لابن رجب (ص: 340)
قال تعالى{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا } [الكهف: 103، 104]
وقال تعالى{ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ } [التوبة: 53]
وانظر إلى حال الخوارج ماذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، في وصفهم، كما في حديث أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، عن الخوارج: ( يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ). (23)
لذلك فالعبد في حاجة إلى أن يلجأ إلى ربه حتى يسدده في جميع أعماله، عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-،: (قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ). (24)
وصدق القائل:
إذا لمْ يكنْ عونٌ من اللهِ للفتى. . . فأكثرُ ما يجني عليه اجتهادُهُ
فبدون توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان أول ما يجني عليه هو اجتهاده وعقله الذي حرم من التوفيق وابتلي بالخذلان.
- العبد يحتاج إلى أن يثبته الله على دينه حتى يلقاه
فكم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما همَّ أن يرقى لعب به موج الهوى فغرق. . . . ، الخلقُ كلُّهم تحت هذا الخطر، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
قال بعضهم: ما العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. (25)
قال الله تعالى لنبيه وخيرته من خلقه {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا } [الإسراء: 74]
وها هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعلمنا كيف يتبرأُ أحدنا من حوله وقوته ويظهر ضعفَ نفسه لربه وخالقه، كما في حديث أَنَس بْن مَالِكٍ -رضي الله عنه-، قال: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-،: (( يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ )).(26)
وعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: (يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ). (27)
وسئلتْ أمٌّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-: مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ " قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: (يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ). (28)
فما أحوجنا أن نستعين بربنا وخالقنا في جميع أمورنا لأننا حقا ضعفاء، لأننا حقا لا نستطيع أن نحرك مثقال ذرة من مكانها، إلا بعون الله وقوته ومشيئته.
---
(1) رواه أبو داود (1522) وأحمد (5/ 244)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1320)
(2) رواه أحمد (3/ 184) وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 228) واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 216)
(3) رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 229) وقال الألباني في الصحيحة (3/ 83): هذا مرسل صحيح
(4) رواه مسلم (537)
(5) رواه مسلم(1855)
(6) سيرة ابن هشام (2/ 172)
(7) رواه البخاري (14)
(8) رواه البخاري (6632)
(9) رواه أبو داود (5124) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (3/ 1396)
(10) رواه أبو داود (5125) وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (3/ 1397)
(11) فتاوى الشبكة الإسلامية (10/ 1565)
(12) رواه مسلم (2577)
(13) رواه البخاري (3034) ومسلم (1803)
(14) رواه البخاري (5673) ومسلم (2816)
(15) الذريعة الى مكارم الشريعة (ص: 119)
(16) مدارج السالكين (1/ 100)
(17) سبل السلام (2/ 648)
(18) الفوائد لابن القيم (ص: 97)
(19) الفوائد لابن القيم (ص: 40)
(20) ديوان الإمام الشافعي (ص: 107)
(21) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 5)
(22) تلبيس إبليس (ص: 35)
(23) رواه البخاري (3610) ومسلم (1064)
(24) رواه مسلم (2725)
(25) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 340)
(26) رواه النسائي (10330) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1013)
(27) رواه الترمذي (2140) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1/ 37)
(28) رواه الترمذي (3522) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 871)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: اللجنة العلمية
- المجموعة: عدد جمادى الأولى 1437هـ
- الزيارات: 13861
إصلاح البيوت
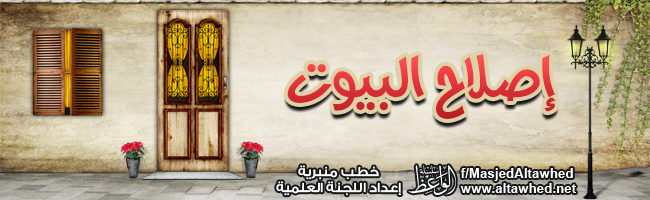
نعمة البيت والسكن أسباب المشكلات المنزلية
وسائل إصلاح البيوت صور من بيوت الصالحين
أولا: نعمة البيت والسكن:
- إن من تمام نعم الله عز وجل على عباده أن جعل لهم بيوتا تؤويهم وتسترهم، وهذه النعمة تستحق الشكر لمن أنعم بها، قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا) [النحل: 80].
قال ابن كثير -رحمه الله-: يَذْكُرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَمَامَ نِعَمِهِ عَلَى عَبِيدِهِ، بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ الْبُيُوتِ الَّتِي هِيَ سَكَنٌ لَهُمْ، يَأْوُونَ إِلَيْهَا، وَيَسْتَتِرُونَ بِهَا، وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا سَائِرَ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ(1).
- كذلك من نعم الله على عباده أن جعل لهم أزواجاً لتتم النعمة عليهم ويحصل لهم السكن والطمأنينة والاستقرار حتى يستطيعوا أن يستقيموا على دينه.
قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21].
قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-: قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ) الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط، (أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة. فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة، (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) يُعملون أفكارهم ويتدبرون آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء(2).
ثانيا: أسباب المشكلات المنزلية:
1- مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-: وَقَدْ دَلَّ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ وَالْفِطْرَةُ وَتَجَارِبُ الْأُمَمِ عَلَى أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَطَلَبِ مَرْضَاتِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِكُلِّ خَيْرٍ، وَأَضْدَادَهَا مِنْ أَكْبَرِ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِكُلِّ شَرٍّ(3).
وعلى هذا فكل مشكلة في أي بيت من بيوت المسلمين السبب الرئيس لحصولها هو مخالفة أمر الله وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-. ومن افتَتَح حياتَه الزوجيّة بالمخالفاتِ الشرعية فهل ينتظِر التوفيقَ من الله؟! أعني بذلك ما بُلِي به بعضُ المسلمين بما أحاطوا به الأعراسَ والأفراحَ من مخالفاتٍ ومُنكَرات قد تنزِع منه البركةَ وتُفقِده التوفيقَ كالتبرّج واختلاطِ الرجالِ بالنساء والتصويرِ المعلَن والخفيِّ والمعازِفِ والأغاني والتعرّي في اللباسِ وتضييع الصّلوات، هذا بالإضافةِ إلى الإسراف في المباحاتِ في التجهيز والحفلات، حتى تحوَّلت بعض الحفلاتِ إلى طغيانٍ ومعاص(4).
وقال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) [الشورى: 30].
قال الطبري -رحمه الله-: يقول تعالى ذكره: وما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) يقول: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم، فلا يعاقبكم بها(5).
2- عدم الرضا بقضاء الله وقدره: إن الله تعالى قدَّر الأرزاق وكتبها قبل خلق السماوات والأرض، فعن عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ -رضي الله عنه- قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)(6).
وقد ميز الله عز وجل بعض خلقه على بعض فخلق منهم الغنى وخلق منهم الفقير، فهو تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال تعالى: (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [العنكبوت: 62]. وقد يظن البعض أن ضيق الرزق سببًا لبعض المشكلات فيلجأ المرء بعد ذلك لطلب الرزق بما يخالف شرع الله، وإنما السبب في ذلك الترف المفرط والتبذير وإنفاق المال في غير حق، وهذا من شؤم الذنب والمعصية.
3- عدم قيام الزوج بواجب القوامة الشرعية: قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ).
قال أبو جعفر الطبري -رحمه الله-: الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم(7).
وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة: 228].
قال ابن كثير -رحمه الله-: وَقَوْلُهُ: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أَيْ: فِي الْفَضِيلَةِ فِي الخُلُق، وَالْمَنْزِلَةِ، وَطَاعَةِ الْأَمْرِ، وَالْإِنْفَاقِ، وَالْقِيَامِ بِالْمَصَالِحٍ، وَالْفَضْلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النِّسَاءِ: 34](8).
فالله عز وجل جعل للرجل على المرأة القوامة وخلقه بهذه الصفة ووهبه درجة عليها
كل ذلك ليقوم على تأديبها والأخذ على يديها إذا وقع منها ما يخالف أمر الله، مثل لو تركت الصلاة، أو لبست زيا مخالفًا للشرع، أو قصرت في حق الله فعليه أن يأخذ على يديها، وإن ما نراه في شوارعنا اليوم من سوء أخلاق وتبرج وسفور وانعدام الحياء من الكثير إلا من رحم ربك، سببه الأساسي هو تقصير الرجل في ما عليه من دور في التربية تجاه من يعول وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)(9). لكن لا يفهم من ذلك أن القوامة تعنى التسلط والتعسف والظلم، وإنما هي الرعاية والحفظ والقيام بالمصالح. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُم)(10).
ثالثا: وسائل إصلاح البيوت:
1-الاستقامة على طريق الله: من أفضل الوسائل المعينة على إصلاح البيوت هي الاستقامة على طريق الله سبحانه واتباع ما جاء عن الله وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله سبحانه وأمره، وإيمانا به، واحتسابا لثوابه، وخشية من عقابه.
وإن تقوى الله عز وجل لها أثر طيب في حياة الرجل وبعد مماته وفي ذريته، وفي قصة الجدار الذي بناه الخضر في سورة الكهف ذكر أن السبب كان كما ذكر الله: (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا) [الكهف: 82]. وفيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة، بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم(11).
ومثلها قوله تعالى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) [النساء: 9].
2- حسن اختيار الزوجة: فينبغي على صاحب البيت أن يختار الزوجة الصالحة بالشروط التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ)(12). وإن كان العقد رغبة في الدين فهو أوثق العقود حالا وأدومها ألفة وأحمدها بدءًا وعاقبة؛ لأن طالب الدين متبعٌ له ومن اتبع الدين انقاد له، فاستقامت له حاله، وأمن زلله. ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فاظفر بذات الدين تربت يداك)(13).
وفي المقابل إذا جاء خاطب للمرأة فلابد أن يُنظرَ في دينه وخلقه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوه تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)(14).
فرغب النبي -صلى الله عليه وسلم- في صاحب الخلق لأن الخلق مدار حسن المعاش ورغب في صاحب الدين لأن الدين مدار أداء الحقوق(15).
3-عمارة البيوت بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)(16).
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي خالية عن الذكر والطاعة فتكون كالمقابر
وتكونون كالموتى فيها(17).
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا)(18).
وعَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ)(19).
قال الَمنَاوِي -رحمه الله-: شبَّه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الذاكر بالحي الذي تزين ظاهره بنور الحياة وإشراقها فيه، فالذاكر يزين ظاهره بنور العمل وباطنه وغير الذاكر ظاهره عاطل وباطنه باطل(20).
وقال الشوكاني -رحمه الله-: التاركُ للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء المشغولين بالطاعة لله عز وجل(21).
وكم من بيوت للمسلمين اليوم ميتة بعدم ذكر الله فيها، بل ما هو حالها إذا كان الذي يذكر فيها هو ألحان الشيطان من المزامير والغناء والغيبة والنميمة والبهتان؟! وكيف حالها وهي مليئة بالمعاصي والمنكرات كالاختلاط المحرم والتبرج بين الأقارب من غير المحارم أو الجيران؟! (22).
4- حسن التعامل بين الزوجين: عَنْ عَائِشَةَ-رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ)(23).
وقد أوصى الله عز وجل عباده بالرفق في المعاشرة وأن تكون قائمة على المعروف. قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 19].
وكان من أخلاقه -صلى الله عليه وسلم- أنه جميلُ العِشرة دائم البِشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنه-، يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني، فقال: (هذه بتلك)(24)، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك -صلى الله عليه وسلم- وقد قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب: 21](25).
رابعا: صور من بيوت الصالحين:
إن استقرار البيوت وصلاح الأسر لهو أعظم سبب من أسباب السعادة، وإن استقر البيت وقام على شرع الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- كان نتاجه بإذن الله غالبا إخراج جيل أشد تعظيمًا لحرمات الله عز وجل، محاكيًا للجيل الأول من السابقين. ومن الأمثلة:
بيوت المهاجرين رضوان الله عليهم وعلى رأسهم بيت أبى بكر الصديق -رضي الله عنه-:
وهو أكمل البيوت حالاً بعد بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- جنَّدَ أبوبكر بيته كله لخدمة دين الله عز وجل.
قَالَتْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ(26).
كان من نتاجه أن أخرج لنا خير مثال للمرأة المسلمة في العفة والطهارة والعلم ألا وهي عائشة -رضي الله عنها- قال الذهبي -رحمه الله-: ولا أعلم في أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بل ولا في النساء مطلقًا امرأة أعلم منها(27).
ومنها بيت الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: بيت العدل والإنصاف لم يختلف عن بيت أبى بكر تخرَّج فيه عبدالله و حفصة زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ومن بيوت الأنصار رضوان الله عليهم: بيتٌ خرَّج سعد بن معاذ وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت، ومنها بيت عمرو بن الجموع ومعاذ بن عفراء وغيرهم -رضي الله عنهم-.
ومن بيوت التابعين: بيت سيرين مولى أنس بن مالك -رضي الله عنه-، كان من نتاجه محمد ويحيي وأنس وحفصة وكل هؤلاء كانوا من العلماء. وبيت مالك بن أنس -رحمه الله- كان فيه ابنته وجاريته كمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ -رحمه الله- حِينَ كَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ الْمُوَطَّأَ فَإِنْ لَحَنَ الْقَارِئُ فِي حَرْفٍ، أَوْ زَادَ، أَوْ نَقَصَ تَدُقُّ ابْنَتُهُ الْبَابَ فَيَقُولُ أَبُوهَا لِلْقَارِئِ ارْجِعْ فَالْغَلَطُ مَعَك فَيَرْجِعُ الْقَارِئُ فَيَجِدُ الْغَلَطَ.
وَكَذَلِكَ مَا حُكِيَ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَأَنَّهُ اشْتَرَى خَضِرَةً مِنْ جَارِيَةٍ وَكَانُوا لَا يَبِيعُونَ الْخَضِرَةَ إلَّا بِالْخُبْزِ فَقَالَ لَهَا: إذَا كَانَ عَشِيَّةً حِينَ يَأْتِينَا الْخُبْزُ فَائْتِينَا نُعْطِيك الثَّمَنَ فَقَالَتْ: ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَقَالَ لَهَا: وَلِمَ؟ فَقَالَتْ: لِأَنَّهُ بَيْعُ طَعَامٍ بِطَعَامٍ غَيْرُ يَدٍ بِيَدٍ. فَسَأَلَ عَنْ الْجَارِيَةِ فَقِيلَ لَهُ: إنَّهَا جَارِيَةُ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ -رحمه الله-(28).
وبيت سعيد بن المسيب فيه ابنته، لَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا - كثير بن المطلب بن أبي وداعة- وَكَانَ مِنْ أَحَدِ طَلَبَةِ وَالِدِهَا فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ أَخَذَ رِدَاءَهُ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: إلَى أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ: إلَى مَجْلِسِ سَعِيدٍ أَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ. فَقَالَتْ: لَهُ اجْلِسْ أُعَلِّمُكَ عِلْمَ سَعِيدٍ(29).
والناظر في سير هؤلاء جميعًا يجد أن بيوتهم قامت على شرع الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، تلك بيوت القوم فلنسلك سبيلهم وطريقتهم جهدنا، فإن لم نبلغ غايتهم، فأخذ القليل خير من ترك الكثير. فلنقتدي بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهدي أصحابه ومن سار على نهجهم حتى تصفو لنا حياتنا ويسلم لنا ديننا.
---
(1) تفسير ابن كثير (4/ 591).
(2) تفسير السعدي (ص: 639).
(3) الداء والدواء، لابن القيم (ص: 18).
(4) المشكلات الزوجية، للشيخ صالح بن محمد آل طالب.
(5) تفسير الطبري (21/ 538).
(6) أخرجه أبوداود(4702)، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (2018/890).
(7) تفسير الطبري (8/ 290).
(8) تفسير ابن كثير (1/ 610).
(9) أخرجه البخاري (893)، ومسلم (4751).
(10) أخرجه ابن أبي شيبة (562)، وصححه الألباني في الإرواء (2156).
(11) تفسير ابن كثير (5/ 186).
(12) أخرجه البخاري (5090)، ومسلم(3625).
(13) أدب الدنيا والدين، لابن أبى الدنيا (ص: 156).
(14) أخرجه ابن ماجه (1968)، حسنه الألباني صحيح الجامع الصغير(270).
(15) انظر حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 607).
(16) أخرجه مسلم (1774).
(17) تحفة الأحوذي للمبار كفوري (8/ 146).
(18) أخرجه مسلم (1770).
(19) أخرجه مسلم (1773).
(20) فيض القدير، للمناوي (5/ 646).
(21) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين، للشوكاني (ص: 20).
(22) المشكلات الزوجية، للشيخ صالح بن محمد آل طالب.
(23) أخرجه أحمد(24427)، وصححه الألباني الصحيحة (1219).
(24) الحديث أخرجه النسائي في الكبرى (8895)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (3251).
(25) انظر تفسير ابن كثير (2/ 242).
(26) أخرجه البخاري (476).
(27) سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 140).
(28) المدخل لابن الحاج (1/ 215).
(29) المصدر السابق.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: اللجنة العلمية
- المجموعة: عدد جمادى الأولى 1437هـ
- الزيارات: 11201
من تصـاحب

فضل الصحبة في الله شروط اختيار الصاحب.
حق الأخوة والصحبة لا صور من الأخوة في الإسلام.
فضل الصحبة في الله:
إن الاجتماع والألفة نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عباده فرضى لهم التوافق والاجتماع والمحبة والألفة وكره لهم الفرقة والتنازع والاختلاف. قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [آل عمران: 103].
قال قتادة -رحمه الله-: قوله تعالى: {وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ }إنّ الله عز وجل قد كره لكم الفُرْقة، وقدّم إليكم فيها، وحذّركموها، ونهاكم عنها، ورضي لكم السمعَ والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضى الله لكم إن استطعتم، ولا قوّة إلا بالله (1). وعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ(2).
وإن من أفضل نعم الله على عبده أن ينعم عليه بأخ يعينه على طاعة الله ورضوانه.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ. (3)
وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: ما أعطى عبد بعد الإسلام خيراً من أخ صالح، وقال أيضاً: إذا رأى أحدكم ودّاً من أخيه فليتمسك به، فقلما تصيب ذلك.
وقد قال بعض الحكماء في معناه كلاماً منظوماً شعراً:
ما نالت النفس على بغية. . . ألذّ من ودّ صديق أمين
مَنْ فاتَه ودّ أخ صالح. . . فذلك المقطوع منه الوتين (4).
وفي القرآن والسنة أدلة كثيرة تدل على عظم الأخوة وفضلها منها:
قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}[الحجرات: 10]، أَيْ: فِي الدِّينِ وَالْحُرْمَةِ لَا فِي النَّسَبِ، وَلِهَذَا قِيلَ: أُخُوَّةُ الدِّينِ أَثْبَتُ مِنْ أُخُوَّةِ النَّسَبِ، فَإِنَّ أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وَأُخُوَّةَ الدِّينِ لَا تَنْقَطِعُ بِمُخَالَفَةِ النَّسَبِ(5).
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- { مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى}(6). فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك، فإن هذا الألم يسري على جميع البدن، كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذا، إذا اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت(7). عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ)(8). وعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)(9). وقد رغب النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأخوة في الله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ-منهم- يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ(10).
شروط اختيار الصاحب:
قال تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكهف: 28].
قال السعدي -رحمه الله-: في هذه الآية الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا يحصى(11).
وقال تعالى: { الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف: 67]
قال القرطبي -رحمه الله-: قَوْلُهُ تَعَالَى: { الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ} يُرِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. { بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} أَيْ أَعْدَاءٌ، يُعَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. {إِلَّا الْمُتَّقِينَ} فَإِنَّهُمْ أَخِلَّاءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ(12).
وقال ابن كثير -رحمه الله-: "كُلُّ صَدَاقَةٍ وَصَحَابَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدَاوَةً إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ دَائِمٌ بِدَوَامِهِ"(13). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: " الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ "(14).
ولله در القائل:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه. . فكل قرين بالمقارن يقتدي.
وذكر الماوردي بعض الْخِصَالُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الإخَاء وقال منها أَرْبَعُ خِصَالٍ:
الْخَصْلَةُ الْأُولَى: عَقْلٌ مَوْفُورٌ يَهْدِي إلَى مَرَاشِدِ الْأُمُورِ. فَإِنَّ الْحُمْقَ لَا تَثْبُتُ مَعَهُ مَوَدَّةٌ، وَلَا تَدُومُ لِصَاحِبِهِ اسْتِقَامَةٌ.
وَالْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ: الدِّينُ الْوَاقِفُ بِصَاحِبِهِ عَلَى الْخَيْرَاتِ، فَإِنَّ تَارِكَ الدِّينِ عَدُوٌّ لِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يُرْجَى مِنْهُ مَوَدَّةُ غَيْرِهِ.
وَالْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ مَحْمُودَ الْأَخْلَاقِ مَرَضِيَّ الْأَفْعَالِ، مُؤْثِرًا لِلْخَيْرِ آمِرًا بِهِ، كَارِهًا لِلشَّرِّ نَاهِيًا عَنْهُ. وَلَا خَيْرَ فِي مَوَدَّةٍ تَجْلِبُ عَدَاوَةً وَتُورِثُ مَذَمَّةً، فَإِنَّ الْمَتْبُوعَ تَابِعُ صَاحِبِهِ.
وَالْخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَيْلٌ إلَى صَاحِبِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي مُؤَاخَاتِهِ.
فَإِذَا اسْتَكْمَلَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي إنْسَانٍ وَجَبَ إخَاؤُهُ، وَتَعَيَّنَ اصْطِفَاؤُهُ. وَبِحَسَبِ وُفُورِهَا فِيهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَيْلُ إلَيْهِ وَالثِّقَةُ بِهِ. (15).
حق الأخوة والصحبة:
والأخوة في الله لا يرجى قبولها عند الله حتى تكون مجردة من أي نفع خاص أو مصلحة خاصة وإنما لابد أن تكون خالصة لله. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ "(16).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "(17).
ومن حقوق الأُخوة والصحبة:
1- الحب في الله: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)(18).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ(19). قال النووي -رحمه الله-: في هذا الحديث فضل المحبة في الله تعالى وأنها سبب لحب الله تعالى العبد(20).
2-الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات: ومن الإعانة بذل المال إلى أخيك المسلم ومعاونته على قضاء حوائجه ومشاركته في فرحه وحزنه وتنفيس عنه كرباته وإن كان صاحب دين تسد عنه دينه كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ(21). والحديث فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك والتجاوز عنهم والمسامحة والإنظار للمعسر وحسن المعاملة، وأن من فعل ذلك فإن الله تعالى يتجاوز عنه بذلك ويغفر ذنبه كما قال تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ } [الرحمن: 60](22).
3- النظر إلى محاسنهم والتغاضي عن عيوبهم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- "وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ"(23).
قال ابن المنذر-رحمه الله-: ويستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة توجب حدا، أو تعزيرًا، أو يلحقه فى ذلك عيب أو عار أن يستره عليه؛ رجاء ثواب الله، ويجب لمن بلى بذلك أن يستتر بستر الله، فإن لم يفعل ذلك الذى أصاب الحد، وأبدى ذلك للإمام وأقر بالحد لم يكن آثمًا(24). فإذا رأى الرجل من أخيه سوءًا فليستر عليه ولينصحه سرًا فإن فعل ذلك فقد نصح لأخيه وإن لم يفعل ولم يرفق به فقد فضحه. قال الشَّافِعِيُّ-رحمه الله-: (مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَخَانَهُ)(25).
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. . . كفى المرء نبلاً أن تعد معائبهْ
4-الدفاع عن إخوانه في غيابهم: عن جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه-،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَا مِنَ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ) (26).
وعَنْ عِمْرَانَ بن حُصين -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: " مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِالْغَيْبِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ، نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "(27).
قال الصنعاني -رحمه الله-: وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُسْتَمِعَ لِلْغِيبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابِينَ فَمَنْ حَضَرَهُ الْغِيبَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَحَدُ أُمُورٍ الرَّدُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ وَلَوْ بِإِخْرَاجِ مَنْ اغْتَابَ إلَى حَدِيثٍ آخَرَ أَوْ الْقِيَامُ عَنْ مَوْقِفِ الْغِيبَةِ أَوْ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ أَوْ الْكَرَاهَةُ لِلْقَوْلِ وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ السُّكُوتَ كَبِيرَةً لِوُرُودِ هَذَا الْوَعِيدِ وَلِدُخُولِهِ فِي وَعِيدِ مَنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمُنْكَرَ؛ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْمُغْتَابِينَ حُكْمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُغْتَابًا لُغَةً وَشَرْعًا(28).
وقال النووي -رحمه الله-: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غِيبةَ مسلم أن يردّها ويزجرَ قائلَها، فإن لم ينزجرْ بالكلام زجرَه بيده، فإن لم يستطع باليدِ ولا باللسان، فارقَ ذلكَ المجلس، فإن سمعَ غِيبَةَ شيخه أو غيره ممّن له عليه حقّ، أو كانَ من أهل الفضل والصَّلاح، كان الاعتناءُ بما ذكرناه أكثر(29).
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ) (30).
من نواقض الأخوة:
1- سوء الظن: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } [الحجرات: 12]
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ )(31).
قال أَبُو حاتم -رحمه الله-: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عَن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه فإن من اشتغل بعيوبه عَن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عَلَيْهِ مَا يرى مثله من أخيه وإن من اشتغل بعيوب الناس عَن عيوب نفسه عمى قلبه وتعب بدنه وتعذر عَلَيْهِ ترك عيوب نفسه وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم وأعجز منه من عابهم بما فيه من عاب الناس عابوه ولقد أحسن الذي يقول
إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا. . . عليك وأبدوا منك مَا كان يسترُ(32)
2-السخرية والاحتقار والهمز واللمز والتنابز: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [الحجرات: 11]
يَنْهَى تَعَالَى عَنِ السُّخْرِيَةِ بِالنَّاسِ، وَهُوَ احْتِقَارُهُمْ وَالِاسْتِهْزَاءُ بِهِمْ، كَمَا ثَبَتَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: (الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ)(33)، وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ: احْتِقَارُهُمْ وَاسْتِصْغَارُهُمْ، وَهَذَا حَرَامٌ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُحْتَقَرُ أَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَ اللَّهِ وَأَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ السَّاخِرِ مِنْهُ الْمُحْتَقِرِ لَهُ(34).
3-الحـــــــــســــــــــــــــد: والحسد من أعظم الأدواء التي تَنقُضُ الأخوة وتورث العداوة والبغضاء بين الناس، عادى إبليس آدم حقداً وحسداً وقتل قابيل هابيل أيضاً حسداً وبغضاً، قال تعالى: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [المائدة: 30]
حسد أخاه فقتله، دب إليه الحسد، وهو داء الأمم السابقة، والحسد يغلى في قلب الشخص، والحسود شخص سيئ الأدب مع الله؛ لأنَّه ينظر إلى نعمة الله على أخيه، فيتمنى لو زالت عنه، قال تعالى: " أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ " [النساء: 54]
قال القرطبي -رحمه الله-: وَالْحَسَدُ مَذْمُومٌ وَصَاحِبُهُ مَغْمُومٌ وَهُوَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا رَأَيْتُ ظَالِمًا أَشْبَهَ بِمَظْلُومٍ مِنْ حَاسِدٍ، نَفَسٌ دَائِمٌ، وَحُزْنٌ لَازِمٌ، وَعَبْرَةٌ لَا تَنْفَدُ. وَقَالَ عبد الله ابن مَسْعُودٍ: لَا تُعَادُوا نِعَمَ اللَّهِ. قِيلَ لَهُ: وَمَنْ يُعَادِي نِعَمَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ(35).
صور من الأخوة في الإسلام:
ومن أعظم صور الأخوة في الإسلام ما كان بين النبي-صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في قصة الهجرة.
وفيها قال أبو بكر -رضي الله عنه- { فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ}(36).
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، النَّاسَ وَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ)، قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ-رضي الله عنه-، فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ: أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هُوَ المُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ)(37).
وهذا من أعظم الأمثلة على الوفاء في الصحبة والأخوة فقد بلغ من وفاء أبى بكر أنه كان يعلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مالم يعلمه غيره -رضي الله عنه-.
وهناك دروس نتعلمها مما حدث بعد هجرة المسلمين إلى المدينة عندما آخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار فمثلاً:
عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ المَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا(38).
---
(1) تفسير الطبري (7/ 74).
(2) أخرجه البخاري(481)، و مسلم (6677).
(3) سنن الترمذي ت بشار (4/ 178) وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
(4) قوت القلوب في معاملة المحبوب (2/ 360).
(5) تفسير القرطبي (16/ 322).
(6) أخرجه مسلم(6678).
(7) شرح رياض الصالحين (2/ 398)، للشيخ محمد بن صالح العثيمين ‘.
(8) أخرجه البخاري(6065)، ومسلم (6618).
(9) أخرجه البخاري (13).
(10) أخرجه البخاري (660). ومسلم (1031).
(11) تفسير السعدي (ص: 475).
(12) تفسير القرطبي (16/ 109).
(13) تفسير ابن كثير (7/ 237).
(14) أخرجه أحمد (8398)قال الألباني حَسَنٌ غَرِيبٌ وانظر مشكاة المصابيح (5019).
(15) أدب الدنيا والدين (ص: 167).
(16) أخرجه البخاري (16)، ومسلم (74).
(17) أخرجه أحمد(7967). قال الألباني ‘: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أبي سليم وهو أبو بلج الفزاري الواسطي، وهو صدوق ربما أخطأ كما قال الحافظ. وانظر الصحيحة (2300).
(18) مصنف ابن أبي شيبة (30443)، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (2539).
(19) أخرجه مسلم (6641).
(20) شرح النووي على مسلم (16/ 124).
(21) أخرجه مسلم (38).
(22) وانظر شرح النووي على مسلم (17/ 21)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 229).
(23) أخرجه مسلم (38).
(24) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 572).
(25) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 140).
(26) أخرجه أبو داود (4884)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع(5690).
(27) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7234)، وقال الألباني ‘: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن – وهو البصري - مدلس وقد عنعنه. وقد وجدت له شاهدا من حديث إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر وأبي الزبير عن جابر مرفوعا. وانظر الصحيحة(1217).
(28) سبل السلام (2/ 692).
(29) الأذكار للنووي (ص: 343).
(30) أخرجه الترمذي (1931)، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (6262).
(31) أخرجه البخاري (6064)، ومسلم (6628).
(32) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 125).
(33) أخرجه مسلم(147).
(34) تفسير ابن كثير (7/ 376).
(35) تفسير القرطبي (5/ 251).
(36) أخرجه البخاري (3652).
(37) أخرجه البخاري (3654).
(38) أخرجه البخاري (2049).